رؤية مختلفة إلى إِرْهاصاتِ النَّهضَةِ فِي الشِّعرِ العربيِّ في القَرْنِ التَّاسِع عَشَر (الحلقة الأولى)
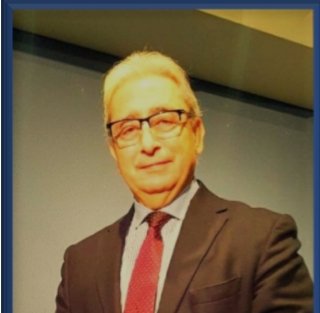
الدكتور وجيه فانوس
دكتوراه في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد
أوَّلا: تمهيد وتوضيح:
أ– البُعد الجُغرافي
لطالما جرى التَّعامل مع ما يمكن أن يُسَمَّى “إرهاصات النَّهضة في الشِّعر العربي في القرن التَّاسِع عشر”، عبر نظر إجمالي يُرَكِّز على بِقاعٍ معيَّنة من الوطن العربي وبهمل بقاعاً أخرى. ولطالما ذهب كثير من دارسي شعر هذه المرحلة إلى أنَّ نتاج شعراء معينين من لبنان ومصر، يشكِّل صورة هذه الإرهاصات؛ من غير ما التفات جديٍّ إلى ما يمكن أن يكون شعراء بلاد عربيَّة أخرى قد قدَّموه في هذا المجال. ولعلَّ هذا المنحى في درس هذه المرحلة من التاريخ الأدبي العربي تأثَّر ببعض الكتابات المؤسِّسَة والمشهورة التي تناولت هذا الموضوع، وكان معظم أصحابها من لبنان أو مصر؛ كما هي حال ما وضعه كلٌّ من الأب لويس شيخو وجرجي زيدان، فضلاً عن شوقي ضيف وآخرون. وقد يكون لهذه الكوكبة من الباحثين المؤسِّسين لدراسة إرهاصات النَّهضة في الشِّعر العربي بعض الحقِّ في اتِّخاذ هذا المنحى؛ فمصر ولبنان شكَّلا، لأسباب عديدة ومتنوِّعة، البقعتين العربيتين الأكثر احتكاكاً بالجديد من خلال حركيَّة المعاصرة المنفتحة، لدى هاتين البقعتين، على الغرب في ذلك الزَّمن؛ لكن هذا لا يعني أن ليس لسائر بقاع العالم العربي حظَّها من إرهاصات النَّهضة الشِّعريَّة في هذه المرحلة.
يمكن الحديث عن العالم العربي في القرن التَّاسِع عشر وفاقا لأسس جغرافيَّة ومكانيَّة، لكلِّ منها خلفيَّات ثقافيَّة قد تتقارب فيما بينها أو تتباعد؛ لكن لكل واحدة من هذه البقاع ما يميزها ببعض أمور عن سواها. ويمكن القول، تالياً، ومن باب التَّأسيس، إنَّ الشعراء العرب في العالم العربي توزَّعوا، في القرن التَّاسِع عشر، على بقاعٍ ثقافيَّة عربيَّةٍ متعدِّدة ومتنوِّعة. فقد كان لكل واحدة من بقاع العالم العربي، من الخليج إلى

المحيط، هواجس وهموم ثقافيَّة تنماز بها عن سواها؛ وكان لكل بقعة، بحكم ما كانت تعاينه وتعانيه من علاقات مع التُّراث الأدبي والتطوُّرات المعرفيَّة الحاصلة وقتذاك، ما ميَّز تجربة النَّهضة عند شعرائها عن تجارب سواهم من شعراء العرب في ذلك الزَّمن. فالعالم العربي لم يكن، في القرن التَّاسِع عشر كتلة ثقافيَّة واحدة، بل مجموع بقاعٍ ثقافيَّة يظلُّ لكل واحدة منها، مهما تقاربت فيما بينها، سمات تنماز بها عن رفيقاتها ضمن هذا المجموع الواحد. صحيح أن الشعراء العرب في هذا القرن كتبوا بلغة واحدة، هي اللُّغَة العَرَبِيَّة؛ وصحيح كذلك، أن منهم من سعى إلى تجديد وتطوير في شعره، ولربما كان له أن يؤثِّر عبر مسعاه هذا في شعر سواه من شعراء مجموعته الثقافيَّة أوغيرهم؛ لكن الصَّحيح أيضاً أن ما من واحد من هؤلاء الشعراء إلاَّ وكان إبناً صادقاً لبيئته الثقافيَّة، بكل ما فيها من معطيات وما تفاعل ناسها ضمنه من عوامل.
جرت العادة، عند الحديث عن التَّحديد الجغرافي للبلاد العَرَبِيَّة أن يُختَصَر هذا بالقول إنَّها إمتداد من الخليج إلى المحيطِ؛ وكأنَّ هذا التَّحديد تعبيرٌ يوحي برسم خطٍّ عَرْضيٍّ يُشَكِّلُ إتِّساع الأرض العَرَبِيَّة مِنَ الخليج العربي شرقاً إلى المحيطِ الأطلسي غربا! إنَّها أرضٌ شاسعة الأمداء تَحوي تََلوُّناتٍ جغرافيَّة كثيرة وتضمُّ مجموعات إنسانيَّة متعدِّدة، تلتقي فيما بينها ضمن تنوُّعات ثقافيَّة متنوعة المناهل والمفاهيم. ولقد شكَّلت هذه البقعة من الكرة الأرضيَّة، وما عليها من ناس، وعبر انتشار الإسلام فيها، وجوداً حضاريَّا اتَّخذ لنفسه العَرَبِيَّة لغة أساسيَّة في الفكر والتَّواصل، والعروبة هُويَّة تراثٍ وحضارةٍ ورؤية مستقبل، والإسلام ديناً لا َتَحْرِمُ سعة انتشاره أديانا أخرى من حقها في الوجود، وحق أتْبَاعِها في ممارسة عباداتهم، بشعائرها وطقوسها، والإيمان بعقائدهم، بمفاهيمها وقيمها؛ كما إن الإسلام لم يحد من انتماء هؤلاء الأقوام إلى العروبة حضارة وقوميَّة وتراثا ومستقبلا. فالعروبة، حضاريَّة كانت أو قوميَّة أو حتَّى دينيَّة، ظلَّت السِّمَة الإنسانيَّة الجامِعَة بين ناس هذه الأرض في مناحي وجودهم كافة.
قد يمكن التعامل مع موضوعات هذا التَّنوُّعِ المكاني الممتد من الخليج إلى المحيط، عبر خمس بقاع مكانيَّة أساس:
i. الجزيرة العَرَبِيَّة، وتضم ما يعرف حاليَّاً بالبحرين وعُمان وقَطَر والإمارات العَرَبِيَّة المتَّحِدَة والكُوَيت واليَمَن والمملكة العَرَبِيَّة السَّعوديَّة.

ii. بلاد الرَّافدين، وتضم ما يعرف حاليَّاً بالعراق.

iii. بلاد الشَّام، وتضم ما يعرف حاليَّاً بالأردن وفلسطين وسوريا ولبنان.

iv. بلاد النِّيل، وتضم ما يعرف حاليَّاً بمصر والسُّودان.

v. المغرب، وتضم ما يعرف حاليَّاً بليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ب- البُعد الثَّقافي:
خضع معظم هذا الامتداد، من المحيط إلى الخليج، قبل انتهاء القرن التَّاسِع عشر الميلادي، لنفوذ الخلافة العثمانيَّة وسلطتها السياسيَّة؛ بيد أنَّه بدأ يشهد، خلال سني هذا القرن التَّاسِع عشر، جملة تبدُّلاتٍ في مجالات السُّلطة السياسيَّة للخلافة العثمانيَّة، بحكم ما اعتور هذه السُّلطة من ضعف وما أحاط بها من مصالح ومطامع للدول الأجنبيَّة فيها. يضاف إلى هذا أن مجموعة من التغيُّرات، في مجالات نضج الوعي الفكريِّ والاجتماعيِّ والسِّياسيِّ والاقتصاديِّ لناس البلاد العَرَبِيَّة، بدأت في الظهور والتأثير. ولربما أمكن القول أن عوامل التفاعل مع الوافد المعرفي والثقافي الغربية، ناهيك بالسياسيَّة، شكَّلت منطلقات التمايز في فعل النَّهضة الشِّعريَّة والسَّعي إليها في بقاع العالم العربي وذلك بحسب مؤثِّرات أساسيَّة لعلَّ من أهمها أربعة تتمثَّلُ في:
i. الموقع المكاني، وقرب هذا الموقع أو بعده عن مراكز القرار والتأثير السياسيين أو الثقافيين.
ii. ما يحيط بهذا الموقع، بالذَّات، من عوامل الاحتكاك مع البيئات الأخرى.
iii. ما يواجهه ناس الموقع، والشعراء من بينهم، من تجارب العيش.
iv. ما يمكن لهؤلاء الشعراء أن يعاينوه ويعانوه من التَّفاعل السَّلبي أو الإيجابي مع ما يكتنف وجودهم من عوامل الموروث والوافد على حدٍّ سواء.
(وإلى اللقاء مع الحلقة التالية: الشِّعر العربي والقرن التَّاسِع عشر)




