أوزمان و البوسيت / بقلم الروائي عمر سعيد


أوزمان و البوسيت
ثمانينيٌ، يكاد لا يُلحظ انحناءُ كتفيه.
تفصل وجهه عن أطرافِ لحيته كِمامةٌ، جعلت بزرقتها ما تدلى أسفلها، كأنه غيمة صغيرة جداً أضاعت دربها إلى السماء، فاحتمت بصدر هذا الثمانيني الوديع.
والقبعة الصوفية الكحلية فوق رأسه، تخفي تحتها آثار عقود ثمانية، ألقت بثقلها على شعره الذي يطل بأطرفه من تحتها إطلالة ضوء تسرب من أسفل باب خشبي، في تلك القرى التي هجرناها وما فعلت.
يظنه الرائي وهو قادم من بعيد، يدفع الپوسيت أمامه جداً، قد خرج مساءً، يروح عن حفيد أو حفيدة مستعيضاً بتلك الصحبة عن الكلاب التي تشغل نساء ورجال اسطنبول صباحاً مساءً.
تتضح ملامحه كلما دنا.
يقترب مبالغاً بابتسامته المخفية وراء الكمامة، والتي تنعكس في بريق عينيه، وتثني ما بان من وجهه.
يهز رأسه، ويبدأ رطنه الوقور..
ليعتقد الملتقي به أنه يعرفه منذ زمن بعيد.
عندما توقفت الپوسيت أمامي، بدت كواحدة من زوايا الاكسسوارات، التي تقام في تلك الأسواق الشعبية، التي تنصبها إيسنيورت، كسوق السبت في جمهوريات محلسي، وسوق الجمعة في أزقة مختار ششمي.
فالعربة( البوسيت) محملة بكل ما لا يؤثر انتهاء تاريخ الصلاحية فيه:
سبحات، قلائد، عقود، أسوار، شبكات شعر، أمشاط، خواتم، دبابيس، و..
أشياء يحتاج المرء ساعة من الوقت، ليتمكن من النظر إليها، إن أراد أن يحيط بها.
توقف بجانبي، وأخذ يرطن بالتركية، محملاً ملامحه الكثير من العاطفة، التي جعلته محبباً، لطيفاً، سهل التواصل، وإن لم أفهم كلامه.
بقيت أنظر إليه مرة، وأخرى إلى الپوسيت، التي يشتعل جوفها بألوان أغطية ما حوت، حتى بدت كأنها مسكبةُ زهور ريفية، يظللُ سماءها سربُ فراشات، يَنسِلُ ألوانَه منها.
كنت منشغلاً بتفاصيل البوسيت، التي خضعت للترقيع في أكثر من مكان، وقد لُفَّ مقبضُها بقماش أصفر، وأحمر، وأخضر.
تتدلى من جنباتها الداخلية أشياءُ، تلمع كابتسامات الأطفال، عندما تناول الرجل سبحة مئوية الحبات، وأرجحها أمام وجهي، وقد أرسل من عينيه نظرة حادة، لا تشبه ملامحه السابقة بتاتاً، فكأنه يقول:
- هي لك، فامسك بها!
تناولت المسبحةَ من الثمانيني، محاولاً أن أفهم، كما أحاولُ في الوقت نفسه ادعاء التماسك.
وقد بدأت رحلةُ قلقي حول ثمن السبحة، وتساؤلاتي الصامتة في كيفية التمكن من المفاوضة حول سعرها..
فكلانا غريب، ولا حاجة لشرح هواجس الغرباء، وحذرهم، وحرصهم المبالغ فيه.
ثم تلفتُّ يمنة، ويسرة، أبحث عمن يقدم المساعدة والترجمة، وقد هممت برد السبحة للرجل، لولا أن ردعني بتكرار النظرة ذاتها، ثم رطن بما لم أفهم منه إلا كلمة الله.
تلك الكلمة التي ما إن سمعتها؛ حتى بعثت فييّ بعض الأمن والطمأنينة والسكون.
فتحت محفظةَ نقودي، وأخرجت منها كل ما فيها من فئات النقد التركي الورقية:
المئتي ليرة، والمئة، والخمسين، والعشرين، والعشرة، وفئة الخمس ليرات.
ثم مددت بها جميعها إليه، منتظراً أن يتناول من بينها ما يعادل ثمن السبحة!
أرجح الرجل رأسه يمنة، ويسرة، وهو يردد: “يوك .. يوك” لا .. لا.
بقيت في ذهولي، واقفاً، لا أعرف مخرجاً لما أنا فيه.
حتى وضع يده في جييه، وأخرج ليرة معدنية، وأشار بها إلي، وهو يقول: “بير ليرة”.
ففهمت أن ذاك هو ثمن السبحة.
أخرجت ليرتين، وامسكتهما بأصابعي الثلاثة: الإبهام والسبابة والوسطى، وقدمتهما له.
لكنه رفض، أن يأخذ أكثر من ليرة واحدة.
ثم نظر إلى شعري، الذي كنت أثبته بقوس معدني أسود، وانحنى، يتناول واحداً من البوسيت، ثم عرضه علي؟!
أخذت القوس المعدني من يده، ومددت له بالليرة الأخرى، فأجاب: “إفيت” نعم
اقتربت منا في هذا الوقت امرأة، راحت، تبعثر ما في العربة، وتنعف ترتيبها بعشوائية، أثارت انزعاج الثمانيني.
ما جعله يطلب منها التوقف عن العبث بما في العربة.
وهو يردد منزعجاً: “يابنجي يوك.. يابنجي يوك”، يقصد لا أجنبي، ويأرجح رأسه استنكاراً لما تفعل.
فهمست المرأة: ” حمة تسلقك، شو غليظ”.
التفتُّ إليها، وسألتها بالعربية: أتعرفين عنه شيئا؟!
فردت: منك شايفه خرفان ومجنون.
أيقنت عندها، أنها من بيئة تطلق الأحكام جذافاً بلا أي رحمة.
قال الرجل: ” تشكرلار”، ثم تابع طريقه.
مشيت خلفه عدة خطوات، حتى بتُّ أمام مدخل صالون الحلاقة الذي غادرته قبل قليل، ولحسن حظي أن الحلاق الذي أتعامل معه، يعرف بعض الإنكليزية.
كان الحلاق يتكىء على كتفه الأيمن في باب المحل، وقد تكتف، وعاكس ساقيه فوق بعضيهما.
وقفت أمامه، وكان هو يعلوني بدرجتين، وسألته:
أتعرف هذا الرجل؟!
قال: ومن في إيسينيورت لا يعرفه، إن بابا “أوزمان” عثمان، وهو درويش طيب، وصوفي نقي.
قلت: ولكنه لم يتقاض مني ثمن ما باعني إلا ليرة واحدة عن كل قطعة.
قال: هذه أسعاره منذ قرابة العشر سنوات.
قلت بلا تردد: ولكنه سيخسر، ولن يتمكن من الاستمرار.
فرد الحلاق: إن محلات التجارة الكبيرة، تحتفظ له بما لا يباع عندها، خاصة تلك الأشياء التي لا يرغب الناس شراءها للونها، أو شكلها، أو لعدم حاجتها، أو لسبب ما.
ولأوزمان موعد، يمر به عليها كل آخر شهر، ليعود منها إلى بيته في شارع طلعت باشا، بكل ما جعل منه مستودعاً مليئاً بما لا يحصى، ففيه من كل ما يخطر على البال أو لا يخطر “بيتانا” أي حبة واحدة،
يقوم بابا أوزمان ببيعها في عربته هذه بليرة واحدة فقط، وهو لا يخرج إلى العمل إلا بعد صلاة يوم الجمعة فيجمع مما يبيع ما يكفيه لقوت يومه، ثم يعود إلى بيته.
أنهيت الحديث مع الحلاق، وخطوت في الاتجاه الذي توغل فيه أوزمان بعربته، لكنه كان قد اختفى، وأدركت أن علي أن أنتظر إلى جمعة قادمة حتى أراه ثانية.
*مقطع من رواية جديدة للكاتب عمر سعيد

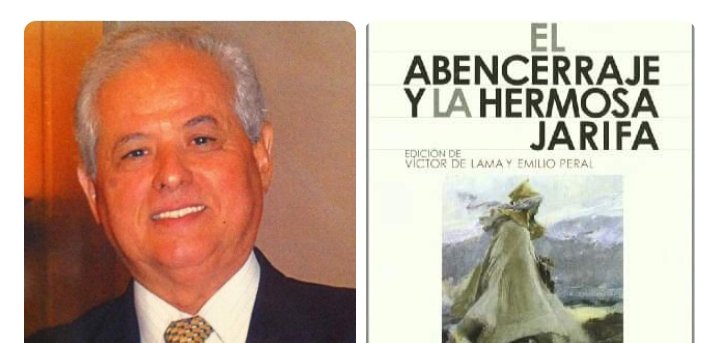



جميل جدا ما تسرده من تفاصيل