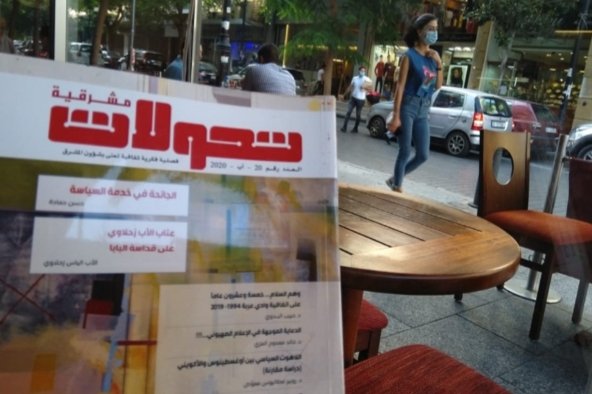رؤيةٌ إلى التَّعامل مع “الآخَرِ” و”المُخْتَلِفِ” وِفاقاً للمفهوم القرآني

رؤيةٌ إلى التَّعامل مع “الآخَرِ” و”المُخْتَلِفِ”
وِفاقاً للمفهوم القرآني
الدكتور وجيه فانوس
[سلسلةٌ تسعى إلى تبيان مناهج من التفاعل الحضاري الإنساني]الحلقة الأولىبسم الله الرحمن الرحيم
يَخْلُطُ، بعضُ النَّاسِ، أحياناً، بين ما هو “آخر”، وما هو “مُخْتَلِفٌ”؛ خاصَّةً وقد صار يسودُ، كثيراً من الأحاديث العامَّةِ، كما النِّقاشاتِ الثقافيَّةِ وتلك السِّياسيَّةِ، تِردادُ لفظَتَي “الآخر” و”المُخْتَلِف”.
“الآخر”، كما يُشير إليه النَّص القرآني، هو الغَيْر؛ ومن هذا القبيل يتحدَّث النَّص القرآني عن الإله الآخر، فيذكر أنَّ عبادة إله آخر، سوى اللهُ، سبحانه وتعالى، تُشَكِّلُ فعل شِركٍ باللهِ، وهي ممارسةٌ مَنْهِيٌ عنها من قِبَلِ ربِّ العالمين، كما أنَّ القِيامَ بها يقودُ صاحبها إلى أن يكون مذموماً ومخذولاً. ولقد ورد هذا الأمر في كثيرٍ من سُوَرِ القرآن الكريم، من مِثْلِ ما هو مذكورٌ في الآية 22 من سورة “الإسراء”، بقوله تعالى{لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً}. ويذكر النَّصُّ القرآنيُّ، الآخرَ، بمفهوم ما هو مختلف في النَّوع عن سواه؛ ومِثالُ هذا، ما جاء في الآية 14 من سورة “المؤمنون”، بقوله تعالى، {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}. فالآخر، في مفهوم النَّص القرآني، هو الغَيْرُ المُتبايِنُ عن الذَّاتِ في النَّوعِ والنَّوعِيَّة.
“المُخْتَلِف”، وفاقاً للنَّص القرآني، المُتَنوِّع؛ ومن هذا ما ورد في الآية 27 من سورة “فاطر”،{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ}؛ وكذلك ما ورد في الآية 69 من سورة “النَّحل”، بقوله تعالى، {ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}؛ وكذلك في قوله تعالى في الآية 106 من سورة المائدة، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}. وكيفما دار الأمر، فإنَّ مراحل التَّغيُّر والتَّنوع الحضاريين في الوجود الإنساني، وخاصَّة في ما تعيشهُ الإنسانيَّةُ في زمننا هذا؛ تقودُ، عمليَّاً، إلى الاحتكاك بالآخر والمختلف.
من البدهي أنَّ التَّفاعل، الصُّحي، مع الآخر، لا بُدَّ وأن يقوم، ههنا، على أسسٍ واضحةٍ ورؤية جلِيَّة؛ وإلاَّ صار ضمنَ ما يمكن تسميته ردَّات الفِعل أو الانفعال. وكما هو مُتعارَفٌ بين النَّاس كافَّة، فإنَّ ردَّات الفِعلِ، كما الانفعال، أمورٌ قد تقودُ إلى عشوائيَّةٍ وعبثيَّةٍ تكتنفانِ الوجود الإنساني، وتُمْعِنان فيه هَدماً وتخريباً. إنَّها أمورٌ لا تنشأ إلاَّ على أهواءٍ متقلِّبةٍ وميولٍ متبدِّلةٍ، لا يمكن أن تكون صالحةً على الإطلاق لبناء وجود إنساني راقٍ، يبحث لذاته عن فاعليَّة مُنْتِجَةٍ تضمن له استمراراً كريماً في العيش. بيد أنَّ السُّؤال الأكبر، في هذا المجال، يكمن في معرفة المنهج القرآني في تفعيل هذا الاحتكاك؛ فهل هو احتكاك يلغي بعضَ أطرافِهِ بعضَها الآخر، أو هو احتكاكٌ يقودُ إلى تَصالُحٍ، أو مساومَةٍ ما، بينَ هذه الأطراف، أو هو احتكاكٌ يقود إلى توليد واحدة أخرى من مراحل الوجود الحضاري للإنسان؟
هذا ما سيكون السَّعيُ، بإذنِ اللهِ، إلى البحثِ فيهِ في الحلقات المقبلة.
وإلى اللقاء.