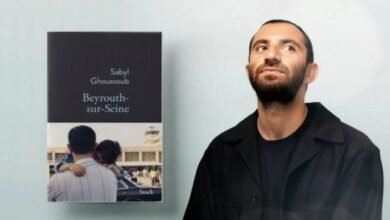“عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” شاعرٌ لم يَمُت، ولَم يكن شاعِراً

الدكتور وجيه فانوس
(رئيس المركز الثقافي الإسلامي)
ثمَّة حقيقةٌ في الشَّاعر “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، الذي غادر جسده دُنيانا قبل خمس سنواتٍ من اليوم؛ وهي حقيقةٌ لُحْمَتُها مِنْ وَرْدِ الشِّعر، وسداها من عَبَقِ كلمات “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” نفسه. إنَّها حقيقةٌ تنهض، رغم ما قد يُبديه بعضُ النَّاسِ مِن تَعَجُّبٍ مِنْها، أو حتَّى مِن رفضٍ لها، على قضيَّتين، أولاهما أنَّ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين لَمْ يَمُت”؛ وثانيتهما، أنَّ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين لم يكن شاعراً”!
يَرِدُ في القضيَّة الأولى، أنَّ عبدالكريم شمس الدِّين، اللُّبنانيُّ المولد والهُويَّة، والعربيِّ المُعتَقَد، والإسلاميِّ الإيمان، والجنوبيّ المَوْلِد والنَّشأة والإقامة، أصرَّ على أنْ لا يغادر أرضَ “الجنوب” طيلة حياتهِ؛ وما قامَ بمغادرةِ “الجنوب”، إلا في تلبيةٍ، قصيرةِ الزَّمنِ، لدعوةٍ مِن أخوانٍ كرامٍ له، في “سوريا” و”العراق” و”تونس”، ليُشارِكَهم مؤتمراً عقدوه، لإنشاد الشِّعر، أو ليحدَّثهم عن تجاربٍ له في بعض فنونِ النَّظمِ ومواضيعهِ.
لقد أصرَّ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، بهذا السُّلوكِ، على اقتناعه بأساسيَّةِ الإلتصاقِ العاشقِ بالأرض في وجودهِ؛ بل إنَّه التزم أرض “الجنوب”، زمنَ الحربِ الصّهيونيَّةِ الغاصبةِ لها ولناسها، بل وللوطن بِرُمَّته، يُقبِّلُ ترابَها بوجدانه، دفاعاً عن حريَّتها وشموخها؛ ولم يغادرْ “الجنوب” أبداً.

آمن “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” أنَّ ثمَّةَ رابطاً عضويَّاً بين تراب “الجنوب” والحياة؛ ولذا، فـ”عبد الكريم” ما انفكَّ ينبضُ حياةً طالما هو مع تراب “الجنوب”، لا فرق أكان جسده فوق هذا التُّراب أو بين أحضانه. ولذا، وبناءً على هذا الفهم للحياة عند “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، فالرُّجل ما برحَ حيَّاً وباقيا وفاعلاً بحيويَّة وجوده هذا.
يَرِدُ في القضيَّة الثَّانية، أنَّهُ، ولَئن وُلِدَ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” سنة 1935، في قرية “مجدل سِلِم”، من أرض “الجنوب”؛ وانتقل، مِن ثَمَّ، إلى منطقة “النَّبطية”، لاستكمالِ تعليمه؛ وتخرَّج، بعد ذلك، “مهندس مساحةٍ”، وتولَّى، تالياً، وظيفةً في “مصلحة الشَّؤون العقاريَّة”، فهذا سِجِلُّ عَيْشِهِ لِخدمةِ ما اكتسيه من عِلمٍ في شؤونِ “هندسةِ المساحةِ”، ولكَسب الرِّزق الحلال.
وإذ يكون لـ“عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” أن يسكن مدينة “النَّبطيَّة”؛ فسكناهُ فيها لم تكن أبداً مجرَّد سكنى إقامة، إذ البيتُ والعملُ، بل هي سكنى ولهٍ وحبٍّ جارفٍ للمدينة وما فيها؛ وليس هذا بعجيب عند “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، فـ”النَّبطيَّة” جزء لا يتجزَّأ من أرض “الجنوب” وذرَّات ترابهِ. ومِمَّا قاله، “عَبْد الكَريم” في النَّبطيَّة، مسقِط رأس العالِم حسن كامل الصَّبَّاح؛ في ديوان “الثَّواني مهيَّأة للوصول” سنة 2015:

أما بداية حياته، في دنيا الشِّعر، وكما تحفظ له سجِّلاتُ تاريخ الأدب، فكانت مع مطلعِ ستِّينات القرن العشرين، سنة 1963؛ إذ نُشِرَ لهُ، عهدذاك، أوَّل أعماله، ديوان “ظِلال”؛ ثمَّ توالت كتاباته الشِّعريَّة، حتَّى بلغت ستَّة عشرَ ديواناً وثماني مخطوطاتٍ؛ وكان كلُّ موضوعات هذا النِّتاج خالصةً للوطنِ والحبِّ والغزلِ والإنسان.
انمازَ شِعر “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” الغَزَلِيِّ، على سبيلِ المثالِ وليس الحصرِ، على الإطلاقِ، بقوَّة العاطفةِ، وربما بكثيرٍ من مظاهرِ عنفوانِ العشق فيها، لكنَّ هذا الشِّعر ما كان ليغادر، أبداً، أنه ينبثق من امتلاءٍ ثريٍّ برصانةِ حضورِ ناظمه؛ وهي رصانةٌ عذبةٌ تتجلَّى بِرِقَّةِ التَّعبير وحيويَّة التَّصويرِ الجماليِّ الموحي القائم على ما يشبه “المنمنمات”، المجتمعة فيما بينها؛ ليكون من اجتماعها هذا، موضوعٌ متكاملٌ هو كيان اللوحة وموضوعها.
يا ثَغْرَها
يا ثغرها المجنون فوق فمي
باللَّهِ ﻻ تغضب
ﻻ ﻻ، وﻻ تعتب
كي ﻻ يظلّ الحبّ
مشتاقاً إلى النّعم
يا موسمَ العنَّاب كيف أنا أغدو
إذا لم يصدق الوعد
وبقيت دوني ليلة عصفت
فيها الرِّياح وهمهم الرعد
قلبي أنا، كم يوجع البرد!
يا ثغرَها
يا حبّتي كرز
زادت حلاوته مراراتي
مذ أنت فوق فمي … فمي تَعِب
يخشى اغترابك في الغد اﻵتي
من سوف يُغني جوع أبياتي؟
ألقاكَ يا لونَ اﻷقاح أرى
لونَ اﻷصيل على مدى أفقي
فأظلّ في ثغرٍ يواعدني
بمواسم العنَّاب والحبق
ويظلّ قلبي في هواك شقي
باللَّهِ ﻻ تغضب
أتعبتني، أتراك ﻻ تتعب؟
كأس الهوى من كفِّ ساقيها
يا خمرةَ العنقود لو تسكب
لسكرت من شفتين ﻻ أعذب
واقعُ الحال، إنَّ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، وكما يروي هو عن نفسه، لم يتعمَّد يوما وضع قصيدة أو حتَّى اختيار موضوع لها؛ بل كانت القصيدة تأتيه من ذاتها. ولهذا السَّبب، كان يمكن له أن ينظم قصيدة في نصف ساعةٍ من الوقتِ، وفي مرَّات أخرى قد يبقى أشهراً من دون أن يأتيه النَّظم؛ وهذا ما كوَّن مفهومه الخاص للتميّيُز الأساس بين من هو “شاعرٌ” ومن هو صانع “شِعر”؛ ولقد أرادَ شمس الدِّين من نفسه أن يكون شاعراً وليس صانع شعر.
ومن شعره الوطنيِّ، في شهداء بلدة “قانا”، الذين قضوا أطفالاً ونساءً وعجائز وشبَّاناُ إثر قصف صهيونيٍّ إجراميٍّ غادر في 18 نيسان سنة 1996:
وعد قانا
قضوا .. ما مضوا
إنهم يطلعون بكلِّ ربيع
براعم وردٍ
ونيسان وعد
يجيئون في موكب مثخن بالجراح
ومنهمر كعيون الصباح
كمثل السَّماء
التي اشتعلت بنجيع اﻷقاح
كما شجر الحور هاماتهم مشرعة
يغنُّون أشواقهم للحياه
وأحلامهم بالنَّجاة
ويتَّجهون جنوبا
يؤدُّون فرض صلاة
قبلتهم ستظلّ جنوبا
ويبقى الجنوب
تراب القداسة والقبلة المرتجاة
وسجادة صلاة
وبعث حياة
ويبدو جليَّاً في هذه القصيدة، نظام “المُنمات” الذي طالما اعتمده “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” في صَوْغِهِ الشِّعريِّ.
يَرِدُ، في سجلاَّت “تاريخ الأدب”، أن “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” وضع قصائده ضمن بنايتي “الشِّعر العامودي” و”شعر التَّفعيلة”، ولم يعتمد أبداً “قصيدة النَّثر”؛ إذ كان لا يؤمن بها، لمنطقٍ قوامُه، كما يذكر، “كيف تكون “قصيدة” وهي “نثر”؛ وكأنَّك تقول “أحكمك بالإعدام براءة”، فكيف تنفِّذ هذا الحكم؟”.

أصدر “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين” دواوينه “ظلال” (سنة 1963) و”مواسم “(سنة 1965) و”الحبّ أحلى” (سنة 1967) و”الفجر المدمى” (سنة 1969) و”قصائدي لكم” (سنة 1972) و”بين حد الحرب والحب” (سنة 1981) و”أغنيات عشق جنونية” (سنة 1982) و”ظل وجهك” (سنة 1993) و”الأعمال الشعرية” (سنة 1997) و”جسد حاصره الحب” (سنة 2000) و”في انكسار جرحي في انتظار فرحي” (سنة 2001) و”أشواق مسافرة” (سنة 2003) و”آخر الكلمات” (سنة 2003)؛ ونشر هذا الديوان بخط يده، كما أصدر ديوان “لصيق بك القلب” (سنة 2007) و”أدرك وجهك خلف الحصار” (سنة 2008)، وديوان “وتبقى القصيدة شاهدة” الذي نشر سنة 2011، ونظم هذا الديوان رغم ما كان يعانيه من ضعف في بصره، إيماناً منه بأنَّه لا يستسلم للضَّعف، وأنَّه يريد أن يشعر بوجوده وأنَّه من دون الشِّعر ينتهي؛ فإن لم يكن ثمَّة شِعرٌ، فلا وجود، تالياً للشَّاعرِ؛ إذ الشَّاعر بشعرهِ وليس بجسده.
أمام هذه المعطيات للقضيَّة الثَّانية، ينهضُ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، عبر هذه السِّيرة الشِّعريَّة، وما رافقها ونتج عنها من وجودٍ إنسانيٍّ، ملحمةً شعريَّة قائمةً بذاتها. ملحمةٌ يمتزج فيها الإنسان بالأرض حتَّى الثّمالة، وتنبثق من هذا الامتزاج جذوة شعرٍ لا تنفك تتألَّق مع كلِّ قراءة فيها ولها.

إنَّ “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، في هذه السِّيرة الشِّعريَّة، هو الأنموذج الرَّائع للشِّعر، كما عاشه إنسان من “الجنوب” في لبنان؛ و”عبد الكريم”، التصق به الشِّعر حتَّى زاحم به نور عينيه، وامتزج به الشِّعر حتَّى اتَّحد به وجوداً وفعلاً ونبضاً. الشِّعر وجود حيٌّ، فها هو “المتنبِّي” بيننا حياةَ شعرٍ، وكذلك هم كبارنا الَّذين قد نختلف في إثبات تواريخ حياتهم وأحداثها؛ بيد أنَّنا نُمعن حياةً عبر شِعريّة وجودهم، الذي هو الشِّعر وليس الشَّاعر على الإطلاق.
أثبت “عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، عاشقُ الأرض، المنصهرُ بالشِّعر حتَّى ذروة ما في الانصهار من توحُّدٍ واتحادٍ ووحدة، أنَّه هو “الشِّعر” بجماليَّة انفتاحه، واستمراريَّة وجوده؛ وليس أبداً “الشَّاعر”، بمحدوديَّة سني عمره وضيق فسحة وجوده.
“عَبْد الكَريم شَمْس الدِّين”، بعد خمسٍ مضين من سنوات غيابه الجسديِّ، لمْ يَمُت؛ فليس هو بشاعرٍ يموت، لأنَّه شِعرٌ باقٍ أبدَ البقاء، تحيَّة إلى وجودهِ الفذ وحياته الرَّائعة، وعرفاناً بفاعليَّته المعطاء في دنيا الأدب.