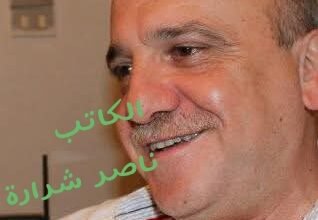سلسلة «دراسات في الشِّعري» (8) شعريَّةُ تَجْديد اللُّغة


الدكتور وجيه فانوس
الشَّعر، وفاقاً للشَّاعر الإنكليزي «صموئيل تايلُر كولريدج» (Samuel Taylor Coleridge) (1772-1834)، هو نتاج الخيال؛ الذي يعملُ على موضوعات الحياة والطَّبيعة؛ ولإنَّ الشِّعرَ نشاطٌ خياليٌّ، فإنَّه يصبحُ بمثابةِ نشاطٍ، يَسعى إلى أنْ يُحَقِّقَ المَثْل الأَعلى في موضوعه. ويَرى «كولردج»، بما أنَّ الألوانَ هي ما يؤدِّي فنَّ الرَّسم، فإنَّ الكلمات هي ما يؤدِّي فنَّ كتابة الشِّعرِ؛ ونظراً لأنَّ مجموعةَ الألوانِ تُحَدِّدُ نَمَطَ اللَّوحةِ التَّشكيليَّةِ وجَوْدَتِها، فإنَّ ترتيبَ الكلماتِ يُعبِّر جمالِيَّاً عن المشاعِرِ والأفكارِ والرُّؤى؛ ويُقَرِّرُ، مِنْ ثَمَّ، نَمَطَ النَّصِّ الشِّعْرِيِّ وَجَوْدَتُه؛ بَيْدَ أنَّ الكلماتَ المرتَّبةَ، ضمن نَمَطِ الوَزْنِ والقافيةِ، لَنْ تَصْنَعْ، وَحْدَها، الشّعر. (163-183:Havens).
مِنَ المُتعارف عليه، بَيْنَ الباحثينَ في شؤونِ اللُّغةِ والمُتعمّقينَ في مجالاتِها، أنَّ عَمَلانِيَّةِ اللُّغةِ تَنْبَني على أنَّها ألفاظٌ وكلماتٌ وأصواتٌ وتنغيماتٌ؛ ذات دلالاتٍ مصطلحيَّةٍ، مُتوافَقٌ عليها، ضمناً، بَيْنَ مستخدمي هذه اللُّغةِ والعارفين بها. وفي هذا الأمرِ، بحدِّ ذاته، ما يفيدُ بأنَّ فاعليَّةَ اللُّغةِ، في جَوْهَرِها، تنهضُ على توافقٍ جَمْعِيٍّ بَيْنَ ناسِها؛ وهذا التَّوافقُ يؤكِّدُ ضرورةَ التزامِ ناسُ اللُّغةِ بهِ، وعدم مخالفتهم لهُ أو انْزِياحهم عنه. فالمخالفةُ، كما الإنزياحُ، في حالِ حصولهما، سيؤدِّيانِ إلى أنْ تتعطَّلِ الدَّلالة أو تتشوَّه. ولكن، ومن جهة أخرى، فإنَّهُ عند تحقَّق «المخالفة» أو «الانزياح»، يحصل ثَمَّة ما يشكِّل، عند متلقِّي اللُّغةِ، صدمةَ استِغرابٍ، أو عدمَ فَهْمٍ للدَّلالةِ التي يقترِحُها «الانزياحُ» الحاصِلُ. يَتأتَّى مِن هذه الحالُ، ما يُمْكِنُ النَّظرُ إليهِ على أنَّهُ «الجَديدُ»، غَيْرِ المتوافَقِ عليهِ بين ناسِ اللُّغةِ؛ وهوَ الأمرً الذي يُمكنُ أنْ يقودَ إلى «إدهاشِ» المُتلقِّي/المُسْتَقْبِلِ؛ وتالياً، إلى إدخالِهِ في حالٍ مِن الوجودِ الشِّعريِّ المتأتِّي عن تفاعُلِهِ مع ما يحصل مِن مخالفةٍ للمتوافَقِ عليهِ مِنَ اللُّغةِ أو انزياحٍ عنه.
تحضرُ اللُّغةُ الشِّعريَّةُ عَبْرَ فاعليَّةِ الانْزياحِ؛ إذ هي مخالفةٌ استشرافِيَّةٌ، تعتمدُ الصَّدمةَ المَبْنِيَّةَ على انزياحٍ دلاليٍّ، يُشير إلى رؤيا شِعْرِيَّةٍ. وتُساهِمُ، هذهِ الرَّؤيا الشِّعْرِيَّةُ، بدورها، في تحقيقِ جماليَّةِ تَلقٍّ/استقبالٍ، تقعُ خارجَ نطاقِ المُتوافَقُ عليهِ مِن دلالاتِ اللُّغةِ، تدعو إلى إنشاءٍ لتوافقٍ جديدٍ على دلالاتٍ لَمْ تَكُنْ مِن قبلُ. ولَئن كانَ هذا الحضورُ للُّغةِ الشِّعريَّةِ، يُشَكِّلُ خُروجاً عن نَمَطِيَّةِ اللُّغةِ المتوافَقُ عليها جَمْعِيَّاً؛ فإنَّ فيهِ ما يؤكِّدُ فاعليَّةَ «هَدْمٍ» ما للُّغةِ؛ والعملَ، مِن ثَمَّ، على إعادةِ تشكيلِ هذه اللُّغة. والتَّشكيلُ «الجديدُ» للُّغَةِ، هو ما قد يُؤَمِّنُ لمتلقِّيها/لِمُسْتَقْبِلِها، مجالاتٍ مِنَ الشِّعريِّ القائمِ على إيحاءاتٍ جديدةٍ وفاعليَّاتٍ، جماليَّةٍ ومفهوميَّةٍ، خارجَ المجالاتِ البلاغيَّةِ المُعتادةِ؛ الأمرُ الذي يقودُ إلى انطلاقٍ باللُّغةِ مِنْ الدَّلالاتِ المُعْجَمِيَّةِ التَّقليديَّةِ إلى بدءِ دلالاتٍ مُعجميَّةٍ جديدة.
يُمكنُ، وِفاقاً، بِكُلِّ ما سبقَ آنِفاً، التَّعامل المفهوميِّ مع جاء بهِ النَّاقد الفرنسيُّ المعاصِر، «ميشيل رفتير» (Michael Riffaterre)، (1924-2006)، من أنَّ النصَّ الشِّعريَّ يقدِّم دلالاته، المفهوميَّة والجماليَّة، بغير طريقة تقديم النَّصِّ النَّثريِّ لدلالاته. (26:Riffaterre) إنَّ النَّصَّ/«الكلام» الشِّعريَّ ينشئ، بهذا الوعيِّ لفاعليَّةِ اللُّغةِ، ضمنَ القصيدةِ، نظاماً لغويَّاً خاصَّاً بهِ؛ ولذا، لا بُدَّ، هَهُنا، مِنْ فَهْمِ مَا يميزُ اللُّغةَ الشِّعريَّةَ مِن لُغَةِ النَّثر. يَتَكَشَّفُ «الشِّعريُّ»، في النَّصِّ/«الكلام»، عَبْرَ نُظُمٍ خاصَّةٍ تنبثقُ مِن وُجُودِهِ الذَّاتيِّ، وتنهضُ على تراكماتٍ شُعورِيَّةٍ ورؤىً انفعاليَّةٍ؛ تقودُ، جميعُها، إلى ابتداعٍ لِمفاهيم وتفاعلاتٍ خارجَ نِطاقِ المُتَّفَقِ عليهِ الجَمْعِيِّ.
أشتُهِرَ عنِ النَّاقدِ الأدبيِّ البلغاريِّ/الفرنسيَّ «تزفيتان تودورف» (Tzvetan Todorov) (1939-2017)، تمييزه بينَ ما يُسَمِّيهِ «لُغَة عادِيَّة» وما يسميه، كذلك، «لغة شعريَّة» (214:Todorov) ويرى «تودورف»، في هذا السِّياق، أنَّ «اللُّغةَ العادِيَّة»، وجودٌ موضوعيٌّ مرتبطٌ بما هو مِنْ خارجِهِ، ولذا فإنَّها وسيلةٌ وليست غايةٌ؛ ومِن هنا، فإنَّها تَجِدُ تسويغاً لها وتفسيراً لمراميها خارجَ وجودِها. أمَّا «اللُّغةُ الشِّعريَّةُ»، فيرى «تودورف»، أنَّها مستقلَّةٌ عن ما عداها، إذ هي ذاتيَّةُ الغايةِ؛ ولذا فإنَّها تَجِدُ تسويغاً لها وإشارةً إلى دلالاتِها، مِنْ داخِلِها وضمنَ مفاهِيمِها التي تدعو متلقِّيها/مُسْتَقْبِلِها إلى التَّوافُقِ عليها. تُستخدمُ «اللُّغةُ العاديَّةُ» وسيلةَ اتِّصالٍ وتواصُلٍ بينَ النَّاسِ؛ في حين أنَّ «اللُّغةَ الشِّعريَّةَ» تَقِفُ في ساحةٍ رحبةٍ للامتاعِ الفنِيِّ والمفهومِيِّ وللتَّأثيرِ الجماليِّ. تتَّسِمُ «اللُّغةُ العاديَّةُ»، بأنَّها مباشرةٌ وتقريريَّةٌ ومنْطِقِيَّةٌ وواضحةٌ؛ في حين أنّ «اللُّغةَ الشِّعريَّةَ» لغةٌ جماليَّةٌ إيحائيَّةٌ، إنَّها «لغةٌ» غريبةٌ عنِ كلِّ ما هو مباشِرٌ أو تقريريٌّ. ليسَ مِن مرامي «اللُّغةِ الشِّعريَّةِ» أنْ تؤمِّنَ لمتلقِّيها/مُسْتَقْبِلِها الإفهامَ، بلْ مِنْ أهمِّ غايتِها تأمين التَّأثير الفَنِّيّ والجَماليِّ.
تتأسَّسٌ فاعليَّةُ «الشِّعريِّ»، هَهُنا، عَبْرَ ما يُمكن أنْ يُسَمَّى بـ «تجديدِ اللُّغةِ»، وبالمُفاجأةِ تَحْديد؛ وتالياً، بالاندهاش من المعنى أو المفهوم الجديدين، اللَّذين يُمكن لهذا التَّجديدِ أنْ يطرحهما للمتلقِّي/المُسْتَقْبِل. فالدَّهشةُ هي تَغَيُّرٌ مِن حالٍ مُتَوَقَّعٍ ومعروفٍ، إلى حالٍ آخر غير مُتَوَقَّعٍ وغير معروفٍ. وهكذا، وبهذا التَّغيُّرِ، يكونُ على «المتَّلقِّي»/«المُسْتَقْبِلِ»، أنْ يُعيدَ النَّظرَ في كثيرٍ مِمَّا كانَ يَعْتَبِرُهُ مِنَ «مسلَّماتِ» التَّواصلِ، لِيَدْخُلَ في رِحابِ الجِدَّةِ وما هو غير مَسْبوقٍ وغير مُتَّفقٌ عليه؛ أكانَ هذا الاتِّفاقُ مِنْ جِهتِهِ هو و«المرسِلِ»، أو كانَ مع «اللُّغةِ» بصورةٍ عامَّةٍ. تَتَحوَّلُ الدَّهشةُ إلى شِعْرِيٍّ يَتَمَثَّلُ أُنْساً بِالجَديدِ أو خَوْفاً مِنهُ، أو ربَّما امْتِحاناً لَه.
أنموذج «بيقولوا زغيَّر بلدي»
بِيْقولوا زْغيَّرْ بَلَدي بالغضب مسوَّر بلدي
الكرامي غضب والمحبِّي غضب والغضب الأحلى بلدي
وبيقولوا قلال ونكون قلال بلدنا خير وجمال
وبيقولو يقولوا شو هم يقولوا شويِّة صخر وتلال
يا صخرة الفجر وقطر النِّدي يا بلدي
يا طفل متوَّج عالمعركي غدي يا بلدي
يا زغير وبالحق كبير وما بيعتدي يا بلدي
تنطلق جدَّة اللُّغة، في نصِّ «بيقولوا زغيَّر»، وهو نصٌّ بالمحكيَّة في لبنان، من المفهوم الذي يقدِّمه «المٌرسِل»، عبر النَّصِّ، عن لفظ ما هو «زغيَّر» (صغير). إنَّ «الصَّغير»، في التَّعبير اللّغويِّ التَّقليدي والمُعتاد والمتوقَّع، هو «الضَّئيل»، أكان في الحجم أو في الوزن أو حتَّى في الوجود، وتالياً، في القوَّة. بيد أنَّ «الزغيَّر» تأتي في النَّصِّ لتعطي مفهوماً مفاجئاً على الإطلاق؛ إذ «الزغيَّر»، ههنا، مُحَصَّنٌ، وحصنه هو الغضب! لقد درج النَّاس، عامَّة، أن لا يأبهوا لغضب من هو «زغيَّر»، بل أن لا يحفلوا به؛ فإذا به، عبر هذا النَّصِّ لـ «الأخوين رحباني» يبرز، بلغتهما الجديدة عنه، صاحب حصنٍ، وحصنه سورٌ من الغضب. لقد بات «الزِّغيَّر» ذا شأنٍ، وهو شأن يدعو إلى الاعتداد به والاهتمام له. وهكذا تبدأ معادلة جديدة في الظُّهور انطلاقاً من اللُّغة الجديدة عن «الزغيَّر». ويتابع مٌرسِلً النَّصِّ لغته الجديدة من خلال طرحة لألفاظ أخرى، ضمن هذه اللُّغة الجديدة؛ فإذا بـ «الكرامة» تتحوَّل من عالم الرِّفعة والتَّرفع، اللذان اعتادت أن تدلَّ عليهما، إلى أنها، هي الأخرى، غضب! وكذلك هو دَيْدَنُ الحالِ مع «المحبَّة»، التي ما اعتاد مفهومها تجاوز التَّسامح والعطف والشَّفقة والألفة، لتصبح، كذلك، وجود غضب! وتكرُّ، على هذا المنوال، سبحة ألفاظ «اللُّغة الجديدة» مُشِعَّةً برَّاقةً بجدَّتها المدهشة على كل صغيرة وكبيرة في النَّص.
ويأتي أنموذج نصِّ «مضوية مضوية»، وهو بالمحكيَّة في لبنان، ليقدِّم أنموذجاً آخر عن اللُّغة الجديدة؛ بيد أنَّه أنموذج لا يقوم على الإدهاش المباشِر والواضح، بقدر ما يقوم على الإدهاش المستتر وراء كثير من جماليَّة ما يمكن أن يعرف بلاغيَّاً بالكناية أو التَّورية:
مزروعة مزروعة جناين داير من دار
وبتضلَّها موجوعة تا تعطي الأرض قمار
مضوية مضوية بالعزّ و بالأشعار
بتموج ومتكية عالزَّنبق ليل نهار
يا بيوت ال بتلالي عاتلال وخلفها تلال
عالي وردك عالي وزراره ما بتنطال
وصِّلني وصِّلني خدني لا تسألني
عاشي نسمة احملني واشلحني بهاك الدار
حلياني وغرقانة بالغيم وبالشَّربين
يا بنيَّة تعبانة بعيونها الحلوين
بكِّتني إيَّامه البيت الحلوي خيامه
بهالباب القدَّاموه في ورد وبنك جرار
كرمِك الله يزيده اللى مشعشع هون وهون
الخير ال بعناقيده عم بيفييِّ عالكون
فتحتِ لحالِك طاقة عالأرض المشتاقة
يا اللي قلبِك باقة حب وإلفة وقمار
يابا يابا يابا يابا يابا أوف لاقونا يا أهل الدار
جبنا الورد غمار غمار لاقونا يا أهل الدار
جمَّعناها نجوم الليل لاقونا يا أهل الدار
وسيجنا داير من دار لاقونا يا أهل الدار
دنيي ترفرف ع الميلين
وطير مشوح مدري منين
بعدك يا نبتات العين تودينا وتزق خبار
يُشْرِقُ «الشِّعريُّ»، ههنا، مِنْ خلالِ لغةِ تَغَيُّرِ الطَّابع التَّقليديِّ والمتعارف عليه للأمور والموضوعات على حدٍّ سواء. من أمثلة هذا، أنَّ الأرضَ، التي هي من تراب وحجر وصخر، تصبح محطَّاً للإحساس ومستقرَّاً للشُّعور، كأنَّها أمرأة حُبلى تُعاني آلام الوضع تمهيداً لتقديم ولادة جديدة تَرْفُدُ بها استمرار الحياة «وبتضلها موجوعة تا تعطي الأرض قمار»؛ وكذلك فإنَّ الأضواء التي تَمْنَحُ النُّور والضَّوءَ، تُضحي مانحةً للعِزِّ والشِّعرِ معاً «مضوية مضوية بالعزِّ وبالأشعار»؛ ولا يمكن إغفال أن الرَّاحة التي هي، عادةً، مدعاة لجمالٍ ما، تُعطي مطرحها للتَّعبِ الذي يُضحي الدَّربَ إلى الجمال والمسبب له «بنيَّة تعبانة بعيونها الحلوين»؛ وعلى هذا المنوال تأتي «الأرض المشتاقة» و»الدِّنيي تْرَفْرِفْ عالمَيْلَيْن» و»نَبْتات العَيْن تودِّينا وْتْزِق خْبار»!
المكتبة:
• Michael Kent Havens, Studies in Romanticism, Vol. 20, No. 2 (Summer, 1981), Published by: Boston University.
• Michael Riffaterre, Text Production, New York: Columbia University Press, 1983.
• Tzvetan Todorov, The Poetics of Prose, Cornell University Press, 1977.
وإلى اللقاء في الحلقةِ العاشرة: «شِعْرِيَّةُ المَسْكُوتِ عَنْهُ في السَّردِ الرِّوائيِّ».
—————
* دكتوراه في النقد الأدبي
من جامعة أكسفورد
(رئيس المركز الثَّقافي الإسلامي)
*نقلا عن صحيفة اللواء اللبنانية