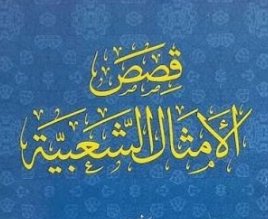متى نتعاملُ معَ أبنائِنا كشخصّياتٍ ناميةٍ ليستْ أفرادًا وأرقامًا؟ سؤالٌ برسمِ القائمينَ على التّربيةِ في بلادِنا!
ركّزت التّربيةُ على بناءِ الشّخصيّةِ السّويّةِ النّاميةِ، بكلِّ أبعادِها الجسمانيّةِ والنّفسيّةِ والفكريّةِ والاجتماعيّةِ، ولكنْ للأسفِ كثيرٌ منَ التّربويّينَ لا يُميّزونَ بينَ: الفردِ – الشّخصِ – الذّاتِ – العينِ – الإنسانِ :وهذهِ المفاهيمُ ليستْ مُترادفاتٍ، فلكلِّ دالِّ مدلولُه، و لكلِّ سلوكٍ معنًى.
فالفردُ هوَ الكائنُ الطّبيعيُّ المالكُ للجسدِ بمعنى رياضيّ، فهوَ: فردٌ منقوصٌ من بُعدِه الاجتماعيِّ والبعدِ الإنسانيِّ، ويُمكن التّعبيرُ عنهُ رياضيًّا بالمعادلةِ التّاليةِ: الفردُ = إنسانٌ – كائنٌ، فالفردُ هو ذلكَ البعدُ البيولوجيُّ والفزيولوجيُّ مثلُه مثلُ الكائنِ الحيوانيِّ سجينِ الغرائزِ .
بينما الشّخصُ يزيدُ عليهِ في أنّه – حسبَ المعادلةِ السّابقةِ- فردٌ + البعدُ الاجتماعيُّ، ونعني بذلك أنَّ الشّخصَ هو فردٌ أصبحَ متشخصنًا باكتسابِه للبُعدِ الإجتماعيِّ “من لغةٍ، وأعرافٍ، وعاداتٍ، وقيمٍ، وتفكيرٍ و… إلخ”.
فالفردُ سابقٌ للشّخصِ زمانيًّا وتراتبيًّا، لأنّه يزيدُ عليهِ بالأنا الاجتماعيِّ مُضافًا للأنا الجسمانيِّ، لذلكَ فالكائنُ البشريُّ يتشكّلُ من طبيعةٍ + ثقافةٍ.
والثّقافةُ ككلِّ مُكتسبٍ يُشخصنُ الفردَ فيكونُ هناكَ تطبّعٌ بجانبِ الطّبعِ، هنا داخلَ المحيطِ الاجتماعيِّ يبدأ تشكّلُ السّلوكاتِ الشّرطيّةِ وفقَ قوانينِ الانعكاسِ الشّرطيِّ عندَ بافلوف، وهنا يبدأُ تعدّدُ “الأقنعةِ” ذاتِ الوجوهِ المتعدّدةِ.
وكلمةُ “ذات” اختفتْ ولكنْ بقيَ يُستَعْمَلُ الجَمْعُ “ذوات” بهذا المعنى نفسِه وقد خالطَتْهُ نَكهةُ سخْرِيةٍ ونُفورٍ مستحدثةٌ أصْبحَتْ ملازمةً له كيفَما دارَ: فإذا قُلْتَ، مثلاً: “أولادُ الذّوات”، قلْتَها بازدراءٍ وقَرَفٍ كأنّما الأَوْلى لهؤلاءِ أن تنشقَّ الأرضُ وتبْلَعَهم!والنّظرة إلى الإنسان باعتبارهِ فَرْدًا منفردًا بذاتِهِ قد زالت.
غير أنّ التّمييزَ الذي يرفعُ بَعْضَ البَشَرِ فوقَ بعضٍ أمرٌ واسعُ الحيلةِ، عَصِيٌّ على الزَوال. هكذا حلّت كلمةُ “شخصيّة” (وتُجْمَعُ على “شخصيًات”) مَحَلَّها. وبقيتْ كلمةُ “عَيْن” وتُجْمَعُ على “أعْيان” مستعملة، وجمْعُها أكثر استعمالاً، في أيّامِنا، من المفرد. فنقعُ عليهِ، مثَلاً، في عبارة “مجلس الأعيان” الذي لا نزال نجده صامدًا بجانب مجلس النوّاب في بعضِ ممالكنا السّعيدة. فالظّاهر أنّ من شروط السّعادة الاقتناعُ بأنّ فلانًا هو عينُه لا غيرُه أي بأنّهُ ذو ذاتٍ ينفردُ بها عن الكثرة من النّاس ويرتفِعُ فوقَها باعتبارِهِ، لا ذاتَ نفسِهِ وحسْبُ، بل ذاتَ الّذين لا ذواتَ لهُمْ أيضًا.
لذلك نجد لدى غالب الأشخاص أقنعة تخفي حقيقة أناهم وذواتهم، فأحيانًا نجد قناعَ الدّين كمظهر بلا جوهر، وحينا قناع العُرف يُخفي قناعة الشّخص، وحينا آخر قناع السّخاء والكرم حاجبًا للشّح والبخل، وهكذا.
هنا يحضرني قول الفيلسوف “جون جاك روسو”: يولد الفرد خيّرًا والمجتمع يُفسده”
فالفساد هو فساد الطّبع وأحد مظاهره هو تلك الأقنعة التي يتلوّن بها الشّخص كالتكلّف والرّياء وغياب الصّدق مع الذّات ومع الآخر.
بينما مدلول إنسان أو إنسانيّ مفهوم يتجاوزهما معنًى وفضلا، فمفهوم إنسانيّ هو تركيب للمفهومين: فرد # شخص. فمدلول إنسان وإنسانيّ يتضمّن معنى الشّخص في بعده العالميّ بعد التّحرّر من مختلف الأقنعة. إذًا فمعادلة الإنسان يمكننا التّعبير عنها كالتّالي: إنسانّي = فرد + شخص + تحرّر، بهذه الخصائص يكتسب الفرد قيمة الصّدق والإخلاص وحبّ الغير وصدق النّوايا والعمل. هذه المعاني كانت إحدى غايات بعض الفلاسفة مثل سقراط socrate والمتصوّفة من رجال الدّين كالغزالي في الإسلام، وباسكال pascal في المسيحيّة والمتصوّفة من الفلاسفة .
فهؤلاء كان مرادهم المكاشفة والصّفاء والنّقاء سواء في علاقة العبد بربه، أو في علاقته بغيره بعيدًا عن الزّيف والخداع والنّفاق، في هذه الحال يتحرّر الفرد من الأنانية إلى الغيريّة، ومن الأثرة إلى الإيثار،ومن الخصوصيّة إلي العالمية. في هذا السّياق أعتقد أنّ الآية الكريمة “إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا “.
ومن مستلزمات هذا التعارف الصّدق في نقل المعرفة والصّدق في التّناصح والحوار وإبداء الرّأي بعيدًا عن زيف الأقنعة. إنّ هذه القيم الإنسانيّة غائبة في مجتمعاتنا العربيّة والإسلامية، حاضرة في المجتمع الغربيّ، فهم تجاوزوا مفهوم الفرد والشّخص كدائرة ضيّقة إلى تجسيد مفهوم الإنسان الذات وله حقوق وعليه واجبات، حرٌّ وآمنٌ ومطيعٌ للقانون في آن واحد.
إنّ من بين أسباب تخلّف شعوبنا وأمّتنا هو عدم وجود المواطن الصّالح، فصلاح الفرد يبدأ من صلاح المدرسة والأسرة، وصلاح المدارس والأسر يتطلّب فلسفة تربويّة تعتمد على قيمنا الذّاتيّة من جهة، وتعزّز بالقيم المعاصرة والحداثة من جهةأخرى. وفق ما وصلت إليه الحقائق العلميّة في علم التّربية وعلم النّفس (الطّفل،المراهق..).
لكنه لا تأثير للمدرسة والأسرة إذا كان المجتمع يضادّها في فلسفة قيمها وفلسفة أهدافها وتوجّهاتها، لذا فالدّولة ومختلف مؤسّساتها إذا لم تتناغم وتنسجم مع المدرسة والأسرة فيكون حالها كحال أعضاء الجسم إذا لم تنسجم مع النّموّ الطّبيعيّ لخلاياه فيحدث أوراما سرطانيّة. لذلك يقول أحد المفكرين: إنّ في صلاح التّربية صلاح المجتمع.
إنّها مقولة صحيحة لكنّهاغير مكتملة لأنّه كذلك قد يصيب المدرسة والأسرة الفساد عندما يكون المجتمع أو الدّولة فاسدتين، أو هذه الأخيرة لا تستجيب أو لا تتناغم مع قيم الأسرة، فيكون هناك شرخ بين هذا المكوّن الثّلاثيّ ((مدرسة- أسرة)، مجتمع، دولة).
إنّ هذه البنية ذات العلاقة المتداخلة هي الّتي عبّر عنها المفكّر الجزائريّ (مالك بن نبي) بشبكة العلاقات الاجتماعيّة حسب فهمنا، فقوّة وضعف المجتمع في قوّتها أو ضعفها. فالتّماسك الاجتماعيّ شرط أساسيّ في نهضة أيّة أمّة، لأنّ به توجد (الإرادة) لدى الفرد والمجتمع والإرادة السّياسيّة لدى الدّولة، هذا ما نلاحظه عند اليابانيّين والغرب، فتقدّم الشّعوب لا يكون بمعجزات، وإنّما يكون بسُنن، ومدى إدراكنا لها (سواء في ميدان التّربية أو ميدان الاقتصاد أو المجتمع…إلخ) بهذه المعرفة يحدث التّغيير وتاليًا التّمكّن، ولا أصدق من قوله تعالى: (لا يغيّر الله ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم.