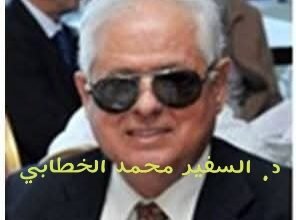صيدة “لا تخافي يا أمي ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ” من ديوان “لمن تغني العصافير “ܠܡܢ ܙܡܪܝܢ ܨܦܪ̈ܐ؟” للشاعر نزار حنا الديراني – دراسة سيميائية-

قصيدة “لا تخافي يا أمي ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ” من ديوان “لمن تغني العصافير “ܠܡܢ ܙܡܪܝܢ ܨܦܪ̈ܐ؟” للشاعر نزار حنا الديراني –
دراسة سيميائية-

د. سومة أحمد محمد خالد
أستاذ مساعد اللغة السريانية في جامعة – المنصورة / مصر
مقدمة
يسعى هذا البحث إلى دراسة الشعر السرياني الحديث، إذ تندر الدراسات الخاصة بالأدب السرياني الحديث سواء أكان شعر أم قصة أم مسرح …إلخ. فقد كتب أدباء السريان المعاصرون في معظم مجالات الأدب الحديث من قصص وروايات ومسرحيات وشعر …إلخ. من ألوان الأدب المختلفة والمتنوعة، أما على الصعيد النقدي والبحثي لم تحظَ هذه الألوان الأدبية بالدراسات الكافية، وعليه يحاول هذا البحث مواجهة هذه الفجوة؛ فالمتتبع للدراسات السريانية يستطيع أن يلمس بوضوح قلة الأعمال الخاصة بدراسة الأدب السرياني الحديث.
أضف لما سبق ندرة الأبحاث التي تقوم على المناهج الحديثة، ومن هنا تحاول الباحثة من خلال هذا البحث دراسة قصيدة سريانية لتقديمها للمتلقي بمنهج حديث وهو المنهج السيميائي حيث يسهم المنهج السيميائي في فتح آفاق جديدة في البحث بعمق.
موضوع البحث: يتطرق هذا البحث إلى دراسة قصيدة “لا تخافي يا أمي”، من ديوان “لمن تغني العصافير” لنزار حنا الديراني –دراسة سيميائية-، إذ تدرس الباحثة من خلال المنهج السيميائي الكشف عن العلامات والإشارات بالقصيدة التي أوردها الشاعر نزار حنا، فهو واحد من الذين أسهموا في إثراء الحركة الشعرية السريانية من خلال انتاجه الشعري.
هدف البحث: يهدف البحث إلى إبراز عدة قضايا منها:
معرفة المنهج السيميائي وتطبيقه على القصيدة، واكتشاف طريقة تحليل هذا المنهج لابراز العلامات والدلالات التي تحتويها القصيدة.
تحليل النص الشعري عند الشاعر نزار حنا الديراني ومعرفة الإمكانيات السيميائية وانعكاسها على المتلقي.
الكشف عن العلاقة بين عتبات النص ومدى انسجامها مع النص الشعري.
إثراء النقد المعاصر بقراءات جديدة للنص الشعري.
الدراسات السابقة: لم يتناول باحث من قبل الديوان الشعري “لمن تغني العصافير؟” سواء بالدراسة أم الترجمة.
مشكلة البحث:
حداثة المنهج السيميائي وقلة الأبحاث خاصة به.
ندرة الدراسات السيميائية للأدب السرياني.
عدم دراسة لغة النص وهي السورث من قبل في الجامعات المصرية، إذ تختلف قواعدها عن قواعد السريانية الكلاسيكية.
قلة المعاجم الخاصة بمفرداتها.
أسباب اختيار النص:
رغبة الباحثة في تقديم دراسة نقدية مستخدمة منهج حديث لم يتبعه كثير من الباحثين في السريانية، وهو المنهج السيميائي.
إثراء المكتبة السريانية ومعرفتها بديوان شعري حديث.
إبراز الجوانب الفنية في القصيدة.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول نص شعري يسهم في تجديد وإثراء اللغة السريانية الحديثة وإيضاح ما تمتلكه من قيم جمالية وفنية مختلفة.
المنهج والإجراءات: تنهج الباحثة المنهج السيميائي، وذلك من خلال: مقدمة، تمهيد، عتبات النص، دراسة القصيدة سيميائيًا، ثم الخاتمة.
وفي الختام أحمد الله وأشكر فضله، وأثني عليه لما أمدني من عون على اتمام هذا العمل.
وما توفيقي إلا بالله،
تمهيد
السيميائية لغة:
هي من الأصل “س و م”، إذ جاء في المعاجم “والسومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة، وسوم الفرس جعل عليه سمة”( )، والسومة بالضم: العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب( )، قال أبو بكر قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة( )، وقال ابن الإعرابي: السيم العلامات على صوف الغنم( ).
السيميائية اصطلاحًا:
تجدر الملاحظة وجود تشابه بين لفظ السيميائية في العربية وبين المصطلح الأجنبي “السيمولوجياSémiologie”، ولا يقتصر الأمر على هذا بل يظهر هذا المصطلح في التراث العربي مثلما ذكر ابن خلدون في كتابه “المقدمة”، فصل “علم أسرار الحروف”، حيث قال: “وهو المسمى بهذا العهد بالسيماء، وهو تفارع علم السيمياء ولا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله”( ).
أما مصطلح السيميائية في العصر الحديث، فيرجع الفضل في مولد هذا العلم إلى “فريديناند دي سوسير” عندما عرّف اللغة بأنها “نظام من العلامات الذي يعبر عن الأفكار، ولذلك فهي مشابهة لنظام الكتابة، لأبجدية الصم، للطقوس والمذاهب الرمزية، لصيغ المجاملة، للإشارات العسكرية…إلخ”( ). ثم ربط “رولان بارت” السيميائية واللسانيات، فصارت جزءًا منها، وبدأت السيميائية في بؤرة الاهتمام حينما قام العالم الأمريكي بيرس بالاهتمام بها ويعد أحد مؤسسي علم السيموطيقا، فاحتلت حيزًا أكبر من النظرية السوسيرية. بناء عليه يمكن القول إن السيميائية تنطوي على علم يبحث في دلالة الإشارات في الحياة وأنظمتها اللغوية، فالسيميائية أو السيمولوجيا Sémiologie تُعني بالعلامة وهي مشتقة من الأصل اليوناني σημείον أي علامة، وقد حظي علم السيميائية أو السيميولوجيا بحظ وافر من الاهتمام لذا كثرت تعريفاته، منها: “العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات: اللغات، والأنظمة والإشارات، والتعليمات”( )، فهي تدرس العلامات المختلفة مثل الصوت، اللون، اللغة …إلخ.
ثم ميز بعض الباحثين بعد ذلك السيميوطيقا Sémiotίque عن السيمولوجيا، وعرفوها بأنها: “فن العلم الذي يدرس بنية الإشارات وعلائقها في الثقافات المختلفة ويدرس بالتالي، توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية”( ). وهناك من يستخدم المصطلحين –أي السيمولوجيا والسيموطيقا- بمدلول ومضمون واحد.
وقد انشقت الاتجاهات السيميائية إلى ثلاثة اتجاهات هي:
السيميائية التواصلية وقصد بها الدال والمدلول والمعنى
السيميائية الدلالية
السيميائية الثقافية الدال والمدلول والمرجع
نهاية القول إن ملامح المنهج السيميائي ظهرت إبان القرن العشرين، وذلك على يد العلماء الغرب، واستقر هذا المنهج بواسطة دي سوسير وبيرس برغم اختلاف التسمية فدعاها دي سوسير باسم السيميولوجيا والتزم به الأوروبيون، وفضل الأمريكان اسم السيميوطيقيا التي أتى بها بيرس.
سيرة المؤلف:
المؤلف هو نزار حنا يوسف الديراني من مواليد 1956، وُلد في قرية ديرابون الكلدانية بمدينة زاخو التي تقع في محافظة دهوك شمال العراق قرب الحدود التركية. حصل على بكالوريس إدارة الاقتصاد من الجامعة المستنصرية. فاز بعدة دورات للهيئة الادارية للمراكز الثقافية للناطقين بالسريانية، كان عضوًا باتحاد الأدباء العرب منذ سنة 1985، عضو مكتب الثقافة السريانية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، شغل منصب رئيس اللجنة الثقافية في جمعية آشور ، عضو اللجنة الثقافية للرهبنة الانطوانية الهرمزدية، عضو المجلس القومي الكلدو آشوري السرياني منذ تأسيسه سنة 2003م، رئيس اتحاد الأدباء السريان منذ سنة 2003 : 2010م على مدى ثلاث دورات متتالية، كما شغل منصب نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق منذ سنة 2004 : 2010م. عمل عضوًا في تحرير مجلة قالا سوريايا، مجلة الأديب السرياني ومديرًا لتحرير مجلة ربنوثا مجلة الأديب العراقي.
إصدارات المؤلف
في الشعر:
شهيد من ديرابون، مطبعة الحوادث سنة 1984م، بالسريانية.
المطر لحن الذكريات، مطبعة أطلس سنة 1986م، بالسريانية والعربية.
صراع الوجود، اتحاد الأدباء العراقيين، مطبعة دار الشئون الثقافية سنة م1994، بالسريانية والعربية.
مقعد شاغر، مطبعة اليرموك سنة 2001م، بالسريانية.
لمن تغني العصافير، مطبعة اليرموك، سنة 1999م بالسريانية.
الصراع الساخن، اصدارات وزارة الثقافة في أقليم كردستان.
كل الأرض عند الحكماء سوية، من اصدارات اتحاد الأدباء والكتاب السرياني، بالسريانية.
ديوان السرة والعشب والخلود
الدراسات الأدبية:
الكيل الذهبي في الشعر السرياني، مطبعة اليرموك، 1989م.
قصيدتنا المعاصرة (قصيدة القرن العشرين) مطبعة اليرموك، 1998م.
الايقاع في الشعر-دراسة مقارنة- بين السريانية والعربية، مطبعة اليرموك، 2000م.
رسالة مارا بن سرافيون، من منشورات المجمع العلمي العراقي، 2000م
ديرابون بين الماضي والحاضر، من منشورات مركز مار كوركيس الثقافي.
أضواء على تاريخ الأدب السرياني بالعربية، من منشورات دار الشئون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، 2007م.
معالم الحداثة في الشعر السرياني، من منشورات مديرية الثقافة والنشر الكوردية، بغداد، وزارة الثقافة، 2014م.
من الشعر العربي الحديث، منشورات مركز مار كوركيس الثقافي، بغداد، 2003م.
من الشعر العربي المعاصر، ترجمة من منشورات دار الهدف للطباعة والاعلام.
في البدء كان الصراع –ديوان شعر-، ترجمة من السريانية إلى العربية، من منشورات دائرة الشئون الثقافية، بغداد، وزارة الثقافة، 2003م.
ترجمات دينية:
درب الصليب بالسريانية، من منشورات مركز مار كوركيس الثقافي، بغداد 2003م
عتبات النص
تصميم الغلاف:
استخدم الرسام اللون الأصفر كخلفية للكتاب ذو درجة هادئة توحي بالراحة، راسمًا باللون الأسود العصافير وهي تطير مغردة؛ إذ أن اللون الأسود هنا يقوي المعني الذي يريد الشاعر توصيله، ويوضح الرموز المرسومة، وذلك برسم قيثارة في الأسفل لتظهر في تناغم مع الطيور والأجراس، واضعًا أجراس جهة اليمين، والقيثارة في الوسط، كأنها ترقص وسط موجات البحر لتوحي بالشاعرية، واحتواء الصورة على أجراس ترمز لأمرين، الأول: إنها تستخدم في المدرسة للتنبيه على بداية ونهاية الحصص، كما أنها مرتبطة بجرس الفسحة الذي يبعث البهجة على التلاميذ. الأمر الآخر: إنها تُستخدم في الكنيسة للصلاة، التي تفيد الجلال والقدسية، ليدمج الشاعر بين المعنيين فهو يريد أن ينبه من خلال ديوانه إلى المراد من ديوانه إلى الطفولة المتمثلة في المدرسة من خلال جرس الفسحة والحصص، وهذا الأمر يحيطه الجلال والوقار المتمثل في جرس الكنيسة.
العنوان:
يعد العنوان فاتحة الكتاب من القضايا المهمة في الدراسات الحديثة، فهو من يجذب القارىء، فإذا تميز العنوان بالتشويق والإثارة فأنه يشجع المتلقي على قرائته، فهو من أهم الإجراءات في أى عمل أدبي، فمن خلاله يمكن التوغل والولوج إلى النص، فهو يلعب دورًا رئيسًا لفهم المعاني والمدلول العام والعبارات في النص الأدبي، فهو العتبة الأولى للنص، وقد أولاه علماء السيميائية اهتمامًا كبيرًا، فهو يبرز العلاقة بين العنوان والنص وبين النص والعنوان( )، على نحو:
عنوان المبدع + المتن الروائي + اسم المبدع + العمل الأدبي
فالعنوان يمثل أساسًا مهمًا في فهم المعاني، فهو يبرز ما في ذهن الأديب من أفكار ويبين المضمون الذي ارتبط في وجدانه ليصله إلى القارىء، كما يمكن القول إنه العنصر الفعال الذي يحدد هوية القصيدة ويعطيها سحرها الانفعالي والخيالي، لذا قيل عنه –أي العنوان- “موضوع الشعرية ليس النص وإنما جامع النص”( )، فهو صورة مصغرة وملخصة لأفكار النص.
عنوان الديوان الشعري –موضع الدراسة- هو: ܠܡܢ ܙܡܪܝܢ ܨܦܪ̈ܐ؟ “لمن تغني العصافير؟”، يحتوي على تسع قصائد شعرية، بالإضافة إلى أربع أوبريتات، وقد اختارت الباحثة القصيدة الأولى منه لدراستها دراسة سيميائية بعنوان “لا تخافي يا أمي”.
من الجدير بالملاحظة أنه لا توجد قصيدة تحمل اسم الديوان، بل أن عنوانه يدل على جوهر ومكنون ما يتضمنه الديوان، إذ يجذب عنوان الديوان القارىء، لعله يتعرف عن إجابة لهذا السؤال، فهو عنوان مشوق لمن يقرأه أو يستمع له، ويتكون عنوان الديوان من عدد قليل من الكلمات، كما يلي: لام الجر + أداة الاستفهام + صيغة مضارعة + اسم
حرف جر+ أداة الاستفهام + اسم فاعل(صيغة مضارعة) + جمع مذكر معرفة
ܠ + ܡܢ + ܙܡܪܝܢ + ܨܦܪ̈ܐ
فالعنوان “لمن تغني العصافير؟” هو أسلوب استفهامي مجازي، وهنا يريد الكاتب أن يصل دلالات سيميائية متنوعة، فغرضه التشويق حيث بث روح الحماسة وإثارة المتلقي لمعرفة القصد مما وراء السؤال، فهو يحمل استفزازًا للمتلقي للإجابة عن السؤال الذي يطرحه، ومعرفة ماهيته، ويتميز العنوان بشاعرية كبيرة صاغها بصيغة المضارعة تغني(ܙܡܪܝܢ)، وهو اسم فاعل جمع مذكر نكرة يدل على زمن المضارعة، والصيغة توحي بتناغم وراحة نفسية تناسب وتتلائم مع الفئة العمرية المقدم إليها، حيث يعني الفعل “غنى” في دلالته المعجمية، طرب وترنم بالكلام الموزون( )، فهو يحمل جرسًا موسيقيًا، ويمثل وقعًا جذابًا على الأذن، كما يشير الفعل أيضًا إلى الاكتفاء وكثرة المال. لكن يأتي اسم الفاعل في السياق ليحدد لنا المعنى المقصود وهو المعنى الأول أي الطرب والترنم، مما يبعث على المتلقي التفاؤل بصوت غناء العصافير وجمال شكلها وخفة حركتها، لذا فهو يوحي راحة وطمأنينة، وهذا السؤال الرئيس يحمل مدلولًا سيميائيًا، فمعناه السيميائي ينطوي على استفهام آخر كامنًا، إذ يتضمن في طياته تساؤلاً ثانيًا ألا وهو هل يقصد الطيور التي تطير في السماء أم للكاتب مقصدًا آخرًا، فهو هنا يدعو المتلقي للاطلاع على مؤلفه ليعرف الإجابة لا سيما إن هذا العنوان لا تحمله أية قصيدة من القصائد الموجودة بالديوان، فهذه الدعوة من المؤلف لاستكشاف إجابة ومحاولة لجذب الانتباه، فهو يشحذ المشاعر في شاعرية وانسيابية متناغمة.
لكن بعد تصفح الكتاب وقراءة القصائد وعناوينها يستنتج منها ما ابتغاه الشاعر بثه، فالسؤال ينطوي عن دلالة عامة، تحمل في طياتها دلالة خاصة.
فالمعنى السيميائي القريب ذو الدلالة العامة هو الطيور المعروفة بجمالها ورقتها وصغر حجمها؛ أما المعنى الباطن ذو الدلالة الخاصة الذي يريده الشاعر هو “الأطفال”، جيل المستقبل وهي مقابلة جميلة من الشاعر لما يتميز به الاثنان من مناظرة في بعض الأمور فكما أن العصافير صغيرة الحجم فأن الأطفال أيضًا بالنسبة للإنسان صغيرة في الحجم والسن، والاثنان يتميزان بالبراءة والجمال، والاثنان يعتريهما الحركة بانسيابية دون مشقة أو تعب، ويؤكد هذا القصد من خلال عناوين القصائد، وهي كالتالي:
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝܼ – لا تخافي يا أمي
ܐܫܘܪܝܢܐ – اشورينا “اسم علم لفتاة”
ܚܠܘܠܐ – حفل
ܣܒܬܝܼ – جدتي
ܐܕܕ – الاله أدد ( إلله المطر في الميثولوجيا العراقيية)
ܩܝܢܬܐ – قينتا “اسم علم لفتاة”
ܓܘ ܒܝܬܐ – داخل البيت
ܫܡܝܪܡ – شميرم “اسم علم لفتاة”
ܓܪܘܣܬܝܼ – مطحنتي
ܐܘܦܪܝܬ ܡܕܪܫܬܐ – أوبريت المدرسة
ܐܘܦܪܝܬ ܫܒܠܐ ܕܡܬܝܼ – أوبريت سنبلة وطني
ܐܘܦܪܝܬ ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ – أوبريت جسر زاخو
ܐܘܦܪܝܬ ܚܨܕ̈ܐ – أوبريت الحصاد
تنطوي العناوين على دلالات وعلامات تعبر عن الصغار والاحتفاء المصاحب لهذه المرحلة والاحتفال، ويبرز العنوان فكر الكاتب المرتبط بالنشء، فهو يكتب بشاعرية من جهة موجهة لهم بأسلوب ناعم ليتقبله ويفهمه من هم في هذا العمر.
كما تؤكد هذه الدلالة السيميائية التي تكمن في اسم “العصافير”، بأنه يعني بها الأطفال، في المقدمة التي افتتح بها الشاعر ديوانه، بأنه يوجه هذا الديوان لهم( )، بجانب احتواء الديوان على صور للأطفال داخله.
يستهل الشاعر أول قصيدة في الديوان بعنوان ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ – لا تخافي يا أمي، وهذا العنوان يلفت انتباه المتلقي لكي يتعرف لماذا صبغ هذه الكلمات بهذا العنوان الذي يثير النفس فهو يتشكل من دلالات سيميائية محورية، على النحو الآتي:
ܠܐ + ܙܕܥܬܝ + ܝܡܝ
لا + تخافي + (يا) أمي
لا ناهية + فعل ماض + اسم مضاف
مع ملاحظة أن حرف النداء محذوف، والجملة بهذه الصورة التركيبية لها قوة دلالية لاصراره بعدم خوف أمه، فلا هنا تفيد الائتناس( ) حيث استخدمت الصيغة في سياق بث الطمأنينة والأنس والحض على عدم الفزع أو الخوف، فقد خرج النهي عن معناه الحقيقي إلى المجازي ليفيد الاستمرارية بالطمأنينة والارشاد برغم من أن النهي من الأقل “الصغير” إلى الأعلى وهي الأم” إلا أن المعنى يتضمن الإلزام والحث على الاطمئنان مع المداومة خلاف الواقع الذي تبث فيه الأم روح الطمأنينة إلى الصغير، وهذه الصورة تدفع الصغار إلى الاعتداد بالنفس والثقة بها وتزرع فيهم القوة لمجابهة الخوف.
فلا أداة نهي تختص بالمنع عن فعل أمر والكف عنه وأتى الفعل في القصيدة فعلًا ماضًا، ولكن دلالته في صيغة المستقبل، ليفيد التجديد والانتقال من عدم الخوف إلى الطمأنينة، وهو يؤثر في النفس، إذ أن دلالته النفسية، تجعل المتلقي يتساءل عن أمر الخوف فيضع أمامه عدة اختيارات عن أسباب الخوف؛ لتأتي الإجابة في الأبيات التالية للقصيدة، ويتوجه بهذا النهي إلى أمه حيث حذف أداة النداء ليدل على مدى القرب بينهما، وهنا يتبادر إلى الذهن هل يقصد الشاعر المعنى السيميائي الواضح في المعنى المعجمي لكلمة “الأم”، وهو أمه الحقيقية أم أنه يقصد الأمهات عمومًا متمثلة في أمه، أم إنه يقصد معنًا سيميائيًا آخر وهو الوطن. وترجح الباحثة أن الدلالة متعلقة بالوطن، وقد ظهرت هذه الدلالة السيميائية في الأبيات التالية:
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ – لا تخافي يا أمي
ܒܕ ܪܥܫܝ̈ ܡܢ̄ ܫܢܬܐ – سيستيقظون من النوم
ܠܫܢܟܼܝ ܝܡܝ – لغتك يا أمي
ܐܢܐ ܒܢܛܪܢ ܠܗ – أنا سأحفظه
ܒܐܬܘܬܟܼܝ ܚܠܝ̈ܐ – بحروفك الجميلة
ܕܝܡ ܒܪܫܡܢ ܠܹܗ – دومًا سأرسمها (سأكتبها)
ܓܘ ܒܝܬܐ ܘܥܕܬܐ – داخل البيت والكنيسة
ܐܢܐ ܒܪܬܡܢ ܠܹܗ – أنا سأترنم بها
هنا يظهر أن الاسم –أي الأم- به تورية فليس المعنى الظاهر هو الأم الحقيقية بل يريد به الوطن، فتكشف الأبيات في طياتها رغم ما يوحي به الفعل “تخافي” من فزع ورعب ولكن الصياغة تحتوي على الأمل بأن هناك من سيحميك ويحفظك ولن يتوانى عن ذلك في أي مكان وزمان، وتكمن أسباب الخوف فيما يتعلق بالسبات الذي فيه أهل وطنه وجهلهم وسبب هذا الجهل والسبات هو نسيانهم للغتهم الأم أي لغة الوطن وهي اللغة السريانية لذا يدعوهم بحفظها وتعلمها وكتابتها والغناء بها.
التعالق السيميائي بين عنوان الديوان وصورة الغلاف وجسد القصيدة:
الـــغـــلاف
الغلاف هو الواجهة الرئيسة لأي كتاب فغلاف الديوان في هذا العمل ذو مستويين بصري ولغوي، تكشف عن علاقة سيميائية دلالية بين عنوان الديوان ولوحة الغلاف، وتصميم لوحة الغلاف وفق أسس ومعايير متوافق عليها بين المؤلف ومصمم الغلاف، لأن اللوحة تختزل المعنى الباطن الذي يحتويه الكتاب وتظهر الدلالات المرادة من الديوان، بناء عليه يمكن القول إن هناك علاقة وطيدة بين الغلاف والنص؛ لأنه يعتبر المرآة التي يُشاهد من خلالها النص أو النصوص.
والمتتبع للوحة الغلاف سيجد أن الشاعر وظف سيميائية معينة ليعبر عن ديوانه، على نحو:
اسم الكاتب: وقد وضعه وسط الغلاف تقريبًا بالسريانية جهة الشمال بالخط الشرقي، وبالعربية جهة اليمين، بخط أقل مما كتب به العنوان، نستشف من ذلك اعتزاز الشاعر بعمله وتفضيله للعمل على شخصه وتقديمه له، ليلفت انتباه القارىء إلى الديوان ليفكر في محتواه، دون إشارة إلى مكان الطباعة أو تحديد لعام محدد، فالغلاف يشمل العنوان والمؤلف فقط، مما يدل على اهتمام الكاتب بعمله وذاته دون غيرهما.
العنوان: وضع المؤلف العنوان أعلى الصفحة متصدرًا إياها، مكتوبًا بخط عريض وكبير ممتد مع ملاحظة أنه رسمه بخط أفقي، بدأه بالخط السرياني الشرقي وأسفله مباشرة دون فاصل ترجمته باللغة العربية، مما يشير إلى تلازم اللغتين سويًا، ولجذب انتباه القارىء سواء يجيد السريانية أو العربية.
اللوحة التجريدية: أبرز ما يجذب المتلقي ويشد نظره الرسم والصور والألوان التي تظهر على الغلاف، من خلاله يستطيع المتلقي معرفة ما يحتويه المضمون بين دفتي الكتاب، إذ استخدم الرسام اللون الأصفر الخافت وهو من الألوان التي تبعث على الارتياح والتفاؤل وعبر عن العصافير والقيثارة والأجراس باللون الأسود فهو من الألوان القوية ليظهر قوة مضمون المعاني التي يريد أن يصلها الكاتب.
نوع الكتابة على الغلاف: صمم المؤلف الكتابة على شكل أفقي، وهي الطريقة المعتادة في كتابة أي كتاب، فاحتل العنوان الجزء العلوي من صفحة الغلاف، أعلى اللوحة واسم المؤلف توسط الغلاف بخط أقل.
الصفحة التالية لصفحة الغلاف: تشمل فضاءًا واسعًا باللون الأبيض يستهل أعلاها عنوان الديوان بالخط الاسطرنجيلي خلاف الخط المكتوب به في صفحة الغلاف، وذلك بخط كبير وعريض ليترك فضاء شاسعًا باللون الأبيض ويبرز اسم المؤلف بالخط السرياني الاسطرنجيلي ثم العربي أسفل الصفحة، ثم يفصل خط أفقي ليكتب بالسريانية مصمم الرسومات وهو الرسام وسام مرقس، بالخط واللغة السريانية ثم العربية على نحو:
ܠܘܚܐ ܕܟܬܒܐ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܡܗܝܪܐ – ܘܣܐܡ ܡܪܩܣ “الرسومات بريشة الفنان القدير الاستاذ وسام مرقس”، ثم رقم (1) في وسط الصفحة.
أما الصفحة التالية فحملت، عنوان المجموعة الشعرية واسم المؤلف والرسام ورقم الطبعة والمكان واسم المطبعة والعام ورقم الايداع ثم الطبعة الثانية.
المقدمة: بعد الصفحة رقم (2) كانت المقدمة بعنوان “كلمة لا بد منها”، تحدث فيها الشاعر دون إمضاء أو توقيع يستشف منها أن من كتبها الاستاذ نزار حنا راصدًا فيها أنها مخصصة للأطفال، وأنها قد قرئت في المهرجانات، دعمًا للأطفال، لتبدأ بعد ذلك القصيدة الأولى.
عناوين القصائد: شمل الديوان 9 قصائد و4 أوبريتات، يحاول الكاتب فيها إثراء اللغة بزيادة المفردات للجيل الناشىء وربطهم باللغة السريانية من خلال الكتابات المتنوعة والتي منها هذا الديوان، فهو يعبر فيها عن العادات والتقاليد التي اعتادوا عليها في المدرسة أو في الحصاد، أو في المحيط بهم في البيت أو المدرسة أو في الاحتفالات. تنقسم العناوين داخل الديوان إلى:
الأول: عناوين تتكون من لفظة واحدة
الآخر: عناوين تتكون من جمل مركبة كما سبق ذكره
العناوين ذات اللفظ المفرد
عنوان القصيدة ما تفيده تحليليًا
ܐܫܘܪܝܢܐ اشورينا اسم علم (لفتاة)
ܚܠܘܠܐ الحفلة مفرد مذكر معرفة
ܣܒܬܝ جدتي مفرد مؤنث مضاف لضمير المتكلم
ܐܕܕ ادد اسم اله آرامي قديم
ܫܡܝܪܡ شميرم اسم علم
ܓܪܘܣܬܝܼ مطحنتي مفرد مؤنث مضاف إلى ضمير متكلم
العناوين المركبة
عنوان القصيدة ما تفيده تركيبيًا
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ لا تخافي يا أمي أداة نهي+فعل ماض+اسم مضاف “جملة فعلية”
ܗܘ ܩܝܢܬܐ ذلك اللحن ( يا قينتا – اسم علم) اسم إشارة للبعيد+مفرد مؤنث معرفة “جملة اسمية”
ܓܘ ܒܝܬܐ داخل البيت ظرف + مفرد مذكر معرفة “شبه جملة”
ܐܘܦܪܝܬ ܡܕܪܫܬܐأوبريت المدرسة مفرد مؤنث (مضاف)+مفرد مؤنث(مضاف إليه) “مركب اسمي”
ܐܘܦܪܝܬ ܫܒܠܐ ܕܡܬܝ أوبريت سنبلة الوطن مفرد مؤنث+مفرد مذكر(مضاف)+دال الإضافة+مفرد مؤنث(مضاف إليه) “جملة اسمية”
ܐܘܦܪܝܬ ܓܫܪܐ ܕܙܟܘ أوبريت جسر زاخو مفرد مؤنث+مفرد مذكر(مضاف)|+دال الإضافة+اسم مكان (مضاف إليه) “جملة اسمية”
ܐܘܦܪܝܬ ܚܨܕ̈ܐ أوبريت الحصاد مفرد مؤنث (مضاف)+دال الإضافة+مفرد مذكر(مضاف إليه) “مركب اسمي”
من الملاحظ فيما سبق أن العناوين المفردة أقل من المركبة بشكل غير كبير، فقد بلغت العناوين المفردة 6 عناوين، والمركبة 7 عناوين، وأن الجملة الاسمية هي الغالبة في الاستخدام، حيث وردت شبه الجملة مرة واحدة فقط، والجملة الفعلية مرة واحدة أيضًا لتفيد الاستمرارية، مقابل خمس جمل أسمية كي تشير إلى الثبوث والاستقرار والتحقيق.
فالمتأمل في الجدول السابق يتبين أن عناوين القصائد تضمنت أسماء علم وأسماء أماكن وبعض الأسماء لشخصيات نسائية وأخرى أسطورية، واسم واحد مذكر، ومن الملاحظ أن الأسماء المؤنثة تحتل مساحة أكبر من الأسماء المذكرة، لإيصال فكرته في التمسك بالتقاليد واللغة، لأن المرأة هي المعول الأساس في المجتمع وهي البنية الرئيسة في بنائه.
العلاقة بين العنوان الخارجي للديوان والعناوين الداخلية للنص:
يتمركز العنوان في موقع استراتيجي مهم متربعًا النص ومقدمته، فالعنوان الخارجي توسط صفحة الغلاف عاليًا ليجذب الانتباه، ويتصل العنوان الداخلي بمتن النص، فهو يعد رسالة تدور وتتمحور حول النص، لتصل إلى المتلقي، فالعلاقة بين العنوان الخارجي والنص علاقة حوارية تفاعلية تنعكس على مستوى الصياغة والمكونات، ومن الملاحظ هو أن عنوان الديوان الخارجي يصنع مع عناوين القصائد الداخلية في الديوان علاقة ضمنية تدور حول اهتمامات الأطفال وسلوكهم.
هنا دلل الشاعر بصياغته للعنوان المضمون المراد إيصاله للمتلقي ليوحي للقارىء مضمونها، إذ لا توجد قصيدة مباشرة تحمل اسم عنوان الديوان، ولكن حملت القصائد المعنى بصورة ضمنية غير مباشرة، فالشاعر يسعى إلى جذب انتباه القارىء وحثه على تتبع الدلالة من خلال القصائد والأوبريتات التي صاغها داخل الديوان.
دراسة القصيدة سيميائيًا
يعنون الشاعر قصيدته بــ “لا تخافي يا أمي”، ليعرض مظهرًا من المظاهر النفسية التي توجد في نفس كل كائن بشري، وهو الخوف وقد صاغه الشاعر كما سبق الإشارة بأداة النهي وفعل ماض، يدل على زمن المستقبل ليعبر عن الاستمرارية، وبث حالة من الطمأنينة، فحمل في طياته أمرًا ضمنيًا بالاطمئنان بأن لا تخاف. وإذا انتقل القارىء ليتسائل عن من يوجه الشاعر هذا الأمر، يجد وجهته متجهة إلى الأم سواء يقصد الأم الحقيقية أم الوطن أم الأمهات جميعًا، وهي تمثل فضاءً ضمنيًا بين الخوف والاطمئنان، فالمخاطب هو الأم ثم يفسر الشاعر سبب خوف الأم وأن هذا السبب لا يدوم، كالتالي:
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ . لا تخافي يا أمي
ܟܕ ܝܘܢ ܙܥܘܪܐ . لأنني صغير
ܗܐ ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ. ها سيأتي اليوم
ܒܕ ܦܝܫܢ ܓܒܪܐ . سأغدو كبير
المربع السيميائي:
الحال المستقبل
لأنني (الآن) هاسيأتي اليوم
الحال المستقبل
صغير سأغدو كبير
يتضح من الأبيات السابقة والمربع السيميائي استنتاج الثنائية الضدية (صغير- كبير) من خلال فضاء زماني سيميائي، فهذه الضدية تسبح في الفضاء الزمني مابين الحاضر والمستقبل، لتبعث الأمل في نفوس الأمهات وبث الاطمئنان بعدم ثبات الحال وإنه سيتغير ويتبدل بقوله سبب خوفك “أنني صغير” لن يستمر طويلاً ولن يدوم، لأنه سيأتي الغد وسأصبح كبيرًا، وهنا يظهر التناقض بين (لا صغير – لا كبير)، ويتضح شبه التضاد في الفترة ما بين كونه صغيرًا إلى أن يبلغ ويصير رجلاً كبيرًا، بأنها لن تستمر محاولاً طمأنتها، ولمزيد من الاطمئنان يحدثها، ولكن المخاطب هنا صامت لا يجيب، فيرسل إليه رسائل طمأنينة قائلاً:
ܚܘܒܟܼܝ ܥܠ ܨܕܪܝ . حبك علي صدري
ܒܙܠܓܼ ܐܝܟܼ ܢܘܗܪܐ . يتلألأ مثل النور
ومن هنا يخاطب الوطن متمثلاً في أمه أنه بعد انتهاء فترة الخوف ويصير كبيرًا فإن حبها فوق صدره ليراه الجميع، واستخدم حرف الجر ܥܠ الذي يعني الفوقية ويفيد العلو دون حرف الجر “في” الذي يفيد الداخل والاحتواء، فالحب يكمن في القلب داخل الصدر، ليرسل دلالة سيميائية بوضوح وقوة هذا الضوء، ليقول لها بأن الجميع سيشاهده “يتلألأ مثل النور” وشبهه في توهجه بأنه لؤلؤ ناصع، إذ حذف المشبه “اللؤلؤ”، وصرح بالمشبه به “النور” الذي يكون واضح للعيان، في استعارة جميلة تشع بالتفاؤل والوضوح، واستخدم الفعل في حالة المستقبل ليدل على الاستمرار والتحقق من هذا التفاؤل.
ثم يرسم صورة الواقع الحالي الذي يوحي بالتشاؤم في الأبيات التالية:
ܐܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܝ . إذا أهل وطني
ܕܡܝܟܼ̈ܐ ܒܣܟܼܠܘܼܬܐ . نائمون في الجهل
ܝܢ ܐܚܘܢܝܼ ܘܚܬܝܼ . أو أخي وأختي
ܬܒܼܗܠܘܢ ܓܘ ܒܪܝܬܐ . تاهوا داخل الكون
فمن الملاحظ في الأبيات السابقة استخدامه أكثر من جملة شرط ليرسم الصورة الحالية أو الأسباب التي تخاف منها الأم وهي من أهل وطنه أو أهل بيته بقوله: “نائمون في الجهل”، أو أخيه أو أخته ضلوا الطريق في هذا الكون الواسع، فرغم هذه الصور التشاؤمية فإنه يطلب منها بعدم الخوف، ويدعوها إلى التفاؤل، ناظرة إلى المستقبل الذي سيتبدل فيه الحال، راسمًا هذه الصورة الإيجابية، في جملة جواب الشرط وما بعدها:
ܒܕ ܪܥܫܝܼ ܡܢ̄ ܫܢܬܐ. سيستيقظون من النوم
ܠܫܢܟܼܝ ܝܡܝ. لغتك يا أمي
ܐܢܐ ܒܢܛܪܢ ܠܗ. أنا سأحفظها
ܒܐܬܘܗܬܟܼܝ ܚܠܝ̈ܐ. بحروفك الجميلة
ܕܝܡ ܒܪܫܡܢ ܠܗ. دومًا سأرسمها
ܓܘ ܒܝܬܐ ܘܥܐܕܬܐ. داخل البيت والكنيسة
ܐܢܐ ܒܪܬܡܢ ܠܗ. أنا سأترنم بها
وقد رسم الصورة بثنائية الضدية
نوم استيقاظ
ما بين النوم والاستيقاظ لن يستمر طويلاً، وهذا ما يؤكده في الأبيات السابقة، ليتحول بعد ذلك من استخدام ضمير جمع المذكر الغائب “هم” الذين يمثلون الزمن الحاضر إلى ضمير المتكلم “أنا” الذي يمثل الزمن الآتي، ويرسم في هذه الأبيات طريقة الاستيقاظ، مستخدمًا الضمير “أنا”، كأن المتكلم هو من يمثل الجيل القادم أي زمن المستقبل محددًا أن الاستيقاظ يتمثل في اللغة بقوله: “لغتك يا أمي” بأن اللغة هي الاستيقاظ وهي العلم والمعرفة للابتعاد عن الجهل لذا سيحفظها مدللاً على ذلك بتشبيه بليغ، وهو: “بحروفك الجميلة” التي تعبر عن النظرة للغة بأن شبه الحروف بإنسانة تتسم بالجمال وهو لم يقل سأكتبها بل قال سأرسمها كأنها لوحة فنية، وهي استعارة حيث حذف المشبه به ليكمل باقي اللوحة الشعرية، أنه لن يقتصر هذا على البيت فقط بل الكنيسة أيضًا، فهو على الدوام سيتغنى بها وعند تجميع الصورة التي رسمها الشاعر بجمال وشاعرية إذ جعل اللغة هي المستقبل، لذا يجب حفظها بحروف جميلة تُرسم في كل مكان ولن يقتصر على ذلك فقط بل يضيف إلى ما سبق الغناء أيضًا ليملأ جُل الحواس من سمع وبصر ولمس.
جملة القول إن الشاعر عبّر بكلمات رقيقة بسيطة موسيقية وبرمزية شديدة عن المستقبل الذي يريد أن يهتم به الأطفال، وهو اللغة لغد مشرق، فقد وائم الشاعر بين المعنى الظاهر في عدم خوف الأم وبين المعنى الضمني للنص لبث الطمأنينة وزرع الأمل في نفوس الصغار والكبار بالاهتمام باللغة.
سيميائية الإيقاع:
الإيقاع هو من يخلق الموسيقى في الشعر، فهو أقوى عناصر الجمال في الشعر، وكما قال شوقي ضيف: “أن الموسيقى لب الشعر وعماده الذي لا تقوم قائمة بدونه”( )، فهو الذي يُطرب له السمع، فالسمع سبق نموه ونشأته الكلام والنطق( )، لأنه أقوى الحواس وأكثر نفعًا من الشم وتمييز المرئيات( ).
تعد هذه القصيدة من الشعر الحديث ويطلق عليه الشعر الحر الذي تخلى عن الأطر القديمة للشعر السرياني، إذ شهدت القصيدة السريانية تحولات بارزة في العصر الحديث بدء من القرن ال19 تأثرًا بالشعر العربي والغربي، فقد تمرد الشعراء على نظام المقاطع في السريانية الكلاسيكية والوزن والقافية التي اكتسبتهم إبان الفتح الإسلامي، وأخذت شكلاً جديدًا يستخدم فيه لغة الشعر والنثر، فبرزت قصيدة النثر التي لا تلتزم بتقييدات الوزن وهو النوع الأول، وتعتمد على عناصر إيقاعية مثل: التوازي، التكرار( )، الجناس وتتخلى من الوزن والقافية، بدافع خلق لغة شعرية جديد( )، وأنتجت أيضًا قصيدة الدعامة أو الوحدة البنائية وهي النوع الثاني.
وتنتمي هذه القصيدة إلى النوع الثاني وهي قصيدة الدعامة ويطلق عليها أيضًا الوحدة البنائية( )، والدعامة عبارة عن توالي مجموعة حركات دون الالتفاف إلى عدد السواكن، إذ تتعدد الدعامات وبتكرارها يتكون الوزن الشعري، فتصبح هي الوحدة الإيقاعية( ). وتجمع بين الشكل القديم والحديث، فهي تتكون من مجموعة أبيات تتشابه في عدد الوحدات الصوتية والقافية( ) وتختلف في الأبيات التي تليها في عددها وقافيتها “حرف الروي”، مكونة إيقاعًا متميزًا.
ويعد الإيقاع أهم العناصر بها، وقد تنوع الإيقاع في القصيدة من خلال التكرار، كالتالي:
تكرار الأصوت:
التكرار الصوتي هو نمط من أنماط التكرار الشائعة يتمثل في تكرار حرف يهيمن صوتيًا في بنية المقطع أو القصيدة، وفي الأسطر التالية، يُلاحظ الآتي:
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ ܟܕ ܝܘܢ ܙܥܘܪܐ لا تخافي يا أمي لأنني صغير
ܗܐ ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ ܒܕ ܦܝܫܢ ܓܒܼܪܐ ها سيأتي اليوم سأغدو كبير
ܚܘܒܟܼܝ ܥܠ ܨܕܪܝ ܒܙܵܠܓܼ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ حبك علي صدري يتلألأ مثل النور
من الملاحظ من الأشطر السابقة تكرار صوت حرف الروي، وهو الراء بحركة فتح طويلة وهي تدل على المذكر المعرفة في السريانية، ويعد حرف الراء من الأصوات المائعة أي بين الشدة والرخاوة( )، مما أكسب الإيقاع حلاوة وجرس موسيقي محبب إلى أذن السامع لما يمتاز به من قيمة صوتية تتسم بالوضوح السمعي( ) وسهولة النطق به والراء مع الحركة الطويلة جعلت تردده في الأذن أوسع مجالاً، فأحدث نوعًا من التناغم والشعور بالهدوء النفسي أعطى للقصيدة موسيقى تتوازى مع الإيقاع لينبه ذهن السامع ما يريد الشاعر قوله فهو ينسجم مع ما أراد الشاعر بثه وهو أن يحقق الطمأنينة للأمهات، فالشاعر يحس على الأمل، فساعد حرف الراء وهو “صوت مكرر”( ) مع حركته المفتوحة أن يؤثر في نفوس السامعيين لا سيما الصغار والثقة بأنهم من يغيرون المستقبل ويصنعون الأمل والمستقبل.
ومن الأحرف المتكررة في الأشطر التالية صوت حرف الروي “التاء” مع حركة الفتح الطويلة، نحو:
ܐܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܝܟܼ̈ܐ ܒܣܟܼܠܘܼܬܐ إذا أهل وطني نائمون في الجهل
ܝܢ ܐܚܘܢܝܼ ܘܚܬܝܼ ܬܒܼܗܠܘܢ ܓܘ ܒܪܝܬܐ أو أخي وأختي تاهوا داخل الكون
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝܼ ܒܕ ܪܥܫܝ ܡܢ̄ ܫܢܬܐ لا تخافي يا أمي سيستيقظون من النوم
التاء من الأصوات التي تشير إلى حاسة اللمس، فالشاعر يريد من الصغير أن يتلمس طريقة والذي يبغيه الشاعر في نهاية القصيدة بحفظه اللغة ويقصد بها “اللغة السريانية” فتكرار حرف التاء خلق نغمًا موسيقيا داخليًا لأنه من الحروف المهموسة الأنفجارية( ) وبتحوله الأول من الحركة التي تدل على المذكر إلى المؤنث جعل في القصيدة ديناميكية وحركة مما أفاد الإيقاع وأعطاه جرسًا موسيقيًا.
فالتحول من حرف الروي “الراء” المفتوح إلى “التاء” المفتوح يعد تحولاً من الأنا إلى الآخر متمثلاً في أهل وطنه لينسجم مع التجربة الوجدانية للشاعر راسمًا الطريق لهم بحفظ اللغة وتعلمها والنطق والكتابة بها.
ثم تكرر حرف الروي “الهاء” في آخر 3 أبيات وهو من الأحرف المهموسة الرخوة، فهو من الحروف التي تُعلي حاسة الشعور( ) والهاء هنا عائدة على اللغة محور وركيزة ما يحاول الشاعر خلقه في نفوس الصغار فجاءت للتأكيد عليها من خلال أفعال تؤكدها، مثل:
أحفظها ” ܒܢܛܪܢ ܠܗܿ “، أرسمها ” ܒܪܫܡܢ ܠܗܿ “، أترنمها ” ܒܪܬܡܢܠܗܿ”، فهي كالمتوالية الهندسية التي تؤكد عزم الجيل القادم الصغير وتحقيقه في المستقبل من خلال تصريف الأفعال في زمن المستقبل.
خلاصة القول إن الشاعر أعطى للقصيدة إيقاعاً موسيقيًا مفعمًا بالحركة بأنه كرر استخدام أكثر من حرف روي وتنقله ما بين المذكر والمؤنث مما أحدث تناغمًا وموسيقى ملحوظة.
تكرار الكلمة:
إن للكلمة المكررة أبلغ الأثر في الكشف عن مضمرات الشاعر النفسية وأحاسيسه الشعورية. ومن الملاحظ هنا أن كلمة يمي “أمي” تكررت 3 مرات بنفس الصيغة والدلالة بشكل غير متوالي، وكلمة الأم لها وقع آخاذ على أي إنسان يسمعها لما تمثله في النفس الإنسانية، فهي تجعل السامع ينتبه لها، وأدى تكرارها إلى تأثير في النفس محبب إليه، فمحور ارتكاز القصيدة هي الأم التي يوجه إليها الخطاب فكشفت عن توفيق الشاعر في اختياره للأم دون الأب لأن الأم ترتبط برمز الطمأنينة والكناية عن الوطن وموطن الحنان، مما أغنى القصيدة في ذهن السامع بتكرارها، فرسم بصورة شعرية جميلة حتمية بث الطمأنينة لها عند الكبر لأن الزمن يتغير ويصير الصغير كبير، فهذه الحركة الزمنية بالتحول من الصغر إلى الكبر أكسبته ديناميكية وجمال في موسيقى القصيدة.
تكرار الجملة:
تكرر عنوان القصيدة ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ “لا تخافي (يا) أمي” في الشطر الأول في صدارة القصيدة ثم في منتصفها بشكل غير متوالي، مما يعكس الأهمية التي يبثها الشاعر لمضمون هذه الجملة فهي المفتاح لفهم مضمون القصيدة، كما حققت توازن هندسي وعاطفي بين ما يعنيه الشاعر من كلام وما يضمره، خلق حالة من الانتباه، فقد أتت الجملة طلبية لشد انتباه السامع ليرسم الأمل المتمثل في النشء الصغير، كما أن تكرار الجملة ساعد على تقوية الإحساس بوحدتها لأنه يعمل على الرجوع إلى نقطة البداية.
الخاتمة:
أهمية العنوان وعلاقته بالنص، وقد ظهر هذا في العنوان الذي عبّر عنه الشاعر بتناغم، يعبر عن جوهر ومدلول الديوان العام “لمن تغني العصافير؟” الذي يقصد بهم النشء القادم.
اللوحة احتوت على العديد من الدلالات السيميائية التي وردت في الديوان، فقدمت مغزى يربط بين المرسوم والمقروء، لتخرج في دلالة جمالية ودلالية.
يظهر من عناوين قصائد الديوان ارتباطه بالبيئة السريانية وحبه لها، والمحافظة على العادات والتقاليد.
برزت بوضوح العلاقة المتينة والقوية بين عنوان الديوان والعناوين الداخلية للقصائد في المتن، وما يرتبط بينهم ضمنيًا في تناغم وشاعرية، تفيد النص.
يتضح من الديوان نظرة الشاعر المتفائلة في مستقبل أفضل.
يظهر من القصيدة مدى حبه وتقديره للغة السريانية، وبأنه سيحفظها ويحاول النهوض بها.
يتبين من القصيدة نظرته المتفائلة في المستقبل وأنه سيحين الوقت، الذي سيتوجهون فيه نحو أفضل.
تنتمي هذه القصيدة إلى قصائد الدعامة أو الوحدة البنائية وهي من افرازات الشعر الحر الحديث.
امتازت القصيدة بإيقاع متناغم سريع من خلال تكرار حرف الروي، والكلمة والجملة.
تعد اللغة بالنسبة إلى الشاعر هي الأمل في غدٍ مشرق.
الترجمة
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ . لا تخافي يا أمي
ܟܕ ܝܘܢ ܙܥܘܪܐ . لأنني صغير
ܗܐ ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ. ها سيأتي اليوم
ܒܕ ܦܝܫܢ ܓܒܪܐ . سأغدو كبير
ܚܘܒܟܼܝ ܥܠ ܨܕܪܝܼ . حبك علي صدري
ܒܙܠܓܼ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ . يتلألأ مثل النور
ܐܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡܬܝ. إذا أهل وطني
ܕܡܝܟܼ̈ܐ ܒܣܟܼܠܘܬܐ . نائمون في الجهل
ܝܢ ܐܚܘܢܝ ܘܚܬܝ . أو أخي وأختي
ܬܒܗܠܘܢ ܓܘ ܒܪܝܬܐ . تاهوا داخل الكون
ܠܐ ܙܕܥܬܝ ܝܡܝ. لا تخافي يا أمي
ܒܕ ܪܥܫܝ ܡܢ̄ ܫܢܬܐ. سيستيقظون من النوم
ܠܫܢܟܝ ܝܡܝ. لغتك يا أمي
ܐܢܐ ܒܢܛܪܢ ܠܗ. أنا سأحفظها
ܒܐܬܘܬܟܝ̈ ܚܠܝ̈ܐ. بحروفك الجميلة
ܕܝܡ ܒܪܫܡܢ ܠܗ. دومًا سأرسمها
ܓܘ ܒܝܬܐ ܘܥܕܬܐ. داخل البيت والكنيسة
ܐܢܐ ܒܪܬܡܢ ܠܗ. أنا سأترنم بها
المصادر والمراجع
إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية ، ط5، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1975م.
إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط2، مكتبة الأنجاو المصرية، القاهرة، 1952م.
ابن جني، سر صناعة الإعراب؛ تحقيق حسن هنداوي، القصيم، ب ت.
ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1956م.
ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق: عبد اللاه محمد الدرويش، ط1، دار البلجيني ومكتبة الهداية، دمشق، 2004م.
ألبير أبونا – أدب اللغة الآرامية – ط1 – بيروت – 1970.
أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، ط1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1987.
بولس السمعانى – فى فرائد الأداب السريانية – المطبعة الكاثوليكية – القدس – 1993.
جيرار جينيت، مدخل لجامع النص؛ ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار ويفال، بيروت، 1989م.
جيروجير؛ ترجمة: منذ عياشي، علم الإشارة السيميولوجيا، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ب ت.
روبرت شولز، السيمياء والتأويل؛ ترجمة: سعيد الغانمي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1994م.
عيسى بربار، محاضرات في مقياس: النقد السيميائي، كلية الاداب، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، الجزائر، 2018م.
فريديناند دي سوسير، فصول في علم اللغة العام؛ ترجمة: أحمد نعيم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ب ت.
محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ط5، دار الثقافة، بيروت، د. ت.
مختار الصحاح، ط5، المكتبة العصرية، بيروت، 1999م.
مراد كامل، زاكية رشدى وآخرون، تاريخ الأدب السريانى، دار الثقافة للطباعة، 1979م.
نزار حنا الديراني، لمن تغني العصافير، ط2، مطبعة اليرموك، بيروت، 2017م.
نزار حنا الديراني، قراءات في القصيدة السريانية المعاصرة، جميل الانتاج والطباعة، 2019م.
نزار حنا الديراني، أوزان الشعر والحلقات المفقودة، دار الكتب، بغداد، 2016م.
نزار حنا الديراني، الإيقاع في الشعر، دار الكتب، بغداد، 2000م.
يعقوب أوجين منا، معجم دليل الراغبين في لغة الآراميين، منشورات مركز بابل، بيروت، 1975م.
رسائل جامعية:
بن سعدة هشام، بنية الخطاب السردي في رواية “شعلة المايدة” لمحمد مفلاح، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، الجزائر، 2014م.
حياة المنورة؛ فوزية فايزي، أسلوب النهي وأغراضه البلاغية في سورة البقرة، رسالة الماجستير، جامعة الشهيد حمة الخضر، كلية الاداب واللغات، قسم الأدب العربي، الجزائر، 2017.
كمال جدي، المصطلحات السيميائية السردية في الخطاب النقدي عند رشيد بن مالك، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، الجزائر، 2012م.
دوريات:
ليلى شعبان ، المنهج السيميائي في تحليل النص الأدبي، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مج1، ع33، الإسكندرية.
مراجع أجنبية:
Costaz, Louis, Dictionnaire Syriaque Francais, Imprimerie Catholique, Beyrouth.
Carl Brockelmann, Lexicon Syriacum, Saxonum Sumptibus Max Niemeyer, Halis, 1928.
G. Hoffmann, Syrisch/Arabische Glossen (Bar Ali), Keil, 1874.
E-Henderson, Lexicon Syriacum, Samuel Bagster and sons, London.
Nicholson – A Literary History f the Arabs – Fisher unwin LTD.- London.
Payne Smith, ACompendious Syriac Dictionary, University of Oxford, London,1903.
Rubens Duval, Lexicon Syriacum “Hassano Bar Bahlule, Tome 1, Reipublice Typographeo, Paris, 1886.
W. Wright – A Short History of Syriac Literature – London – 1894.
ملخص البحث
قصيدة “لا تخافي يا أمي” من ديوان “لمن تغني العصافير” لنزار حنا الديراني
–دراسة سيميائية-
سومة أحمد محمد خالد
قسم اللغات الشرقية/سامي- كلية الآداب – جامعة المنصورة – المنصورة – مصر.
البريد الالكتروني: yahoo.com@dr.souma_khaled
الملخص العربي: يسعى هذا البحث إلى دراسة قصيدة “لا تخافي يا أمي” من ديوان “لمن تغني العصافير”، للأديب نزار حنا الديراني، وهو من الأدباء الذين يحاولون التجديد في الشعر السرياني.
وقد اتخذت الباحثة المنهج السيميائي إجراء لتفكيك شفرات هذا النص، إذ احتوت القصيدة على العديد من الدلالات السيميائية بداية من تصميم الغلاف، وعنوان الديوان والقصيدة ومرورًا بدراسة القصيدة سيميائيا، وسيميائية الإيقاع، فالخاتمة، ثم المصادر والمراجع.
الكلمات الدالة: السيميائية، شعر سرياني، سيميائية الإيقاع، ديوان لمن تغني العصافير، نزار حنا الديراني.
Poem “Do not afraid my mother”, of the divan “To whom the birds singing”, by Nizar Hanna Al- Dirani “Semiological Study”
Souma Ahmed Mohamed Khaled
E-Mail: yahoo.com@dr.souma_khaled
Abstract: This research seeks to study of a poem “do not afraid my mother”, of the divan “to whom the birds singing”, by the writer Nizar Hanna Al-Dirani, one of the writers who are trying to renew in Syriac poetry.
The researcher has taken a semiological method to decipher the codes of this text.
The poem contains a lot of semiological clues beginning in the design of the cover and title of the divan and poem, passing through studying of the poem semiological, rhythm, conclusion, sources and references.
Key word: Semiology, Syriac Poetry, Rhythm Semiology, divan “to whom the birds singing”, Nizar Hanna Al-Dirani.